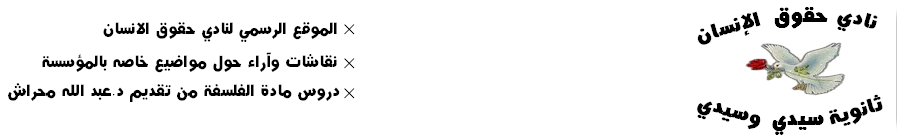abdo2.mohrach
إدارة الموقع


عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
 |  موضوع: مجزوءة الاخلاق من اعداد الفريق التربوي بفاس موضوع: مجزوءة الاخلاق من اعداد الفريق التربوي بفاس  الثلاثاء أبريل 06, 2010 3:18 am الثلاثاء أبريل 06, 2010 3:18 am | |
|
الواجــب
الواجب والقانون والحرية والمعاملات والحقوق والسلوك والضمير كلها مفاهيم تندرج ضمن الأخلاق، لكن يجب التمييز بين الأخلاق (Morale) والإتيقا (ethique). الأولى مبحث نظري من المباحث الكبرى للفلسفة؛ يمتاز بكونه علما معياريا؛ يهتم بتحديد القيم العليا الموجهة للفعل الإنساني ورسم معايير هذا الفعل وغاياته المقصودة. أما الإتقيا فهي " فلسفة الأخلاق " بحيث أنها لا تسائل القيم والمعايير والغايات في حد ذاتها بقدر ما تسائل التصورات الفلسفية المشيدة على تلك القيم الإنسانية. بعد هذا التمييز الأساسي لابد أن نتساءل عن معنى الواجب وعلاقته بالحقوق ؟ أهو إلزام وإكراه أم التزام وحرية ؟ ونتساءل عن دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة في ترسيخ مفهوم الواجب وتركيزه وتوجيه تصرفات الفرد وفق قيم يعتقد فيها وهو مقتنع بها لكن ما هو الوعي الأخلاقي أهو التزام عقلي أم ميل طبيعي ؟ وما هي القيمة ؟ وما هو المعيار الملائم لوعيها ووعي قيمتها وأهميتها ؟ يمكن تركيب هذه التساؤلات وتجميعها في المحاور الثلاثة التالية :1- الواجب بين الإلزام والالتزام.2- الوعي الأخلاقي.3- الواجب والمجتمع.المحور الأول : الواجب بين الإلزام والالتزام.يبدو أن مفهوم الواجب " هو من المفاهيم الأخلاقية الحديثة فهو يشكل المقولة الأساسية والوحيدة للأخلاق .. حسب إريك فايل ". ذلك أن فلسفات الأخلاق القديمة كما نعثر عليها في الفلسفة اليونانية قد ركزت اهتماماتها على مفهومي " الفضيلة " و" السعادة " (راجع الأخلاق إلى نيكوماخوس لأرسطو مثلا) أو على مفهومي " اللذة " و" المنفعة " (انظر أخلاقيات الأبيقورية والرواقية).والواجب تحديدا " أمر أخلاقي " ملزم لكل الناس، إلا أنه أمر إشكالي فهل هو واجب قطعي يعبر عن قانون العقل وندائه ؟ أم هو استجابة لميل ونزوع الأهواء ؟ إن اختلاف الفلاسفة بهذا الصدد تحكمه حجج وحيثيات عدة ومتضاربة يمكن صياغتها كما يلي:الإنسان جسد وعقل، يعني ضمير وأهواء . وفي خضم هذا الصراع وهذه التجربة ينبثق المبدأ العقلي للواجب الذي يهيمن ويفرض أوامره على الإنسان بشكل إلزامي وإكراهي فيلزمه بممارسة هذا السلوك أو ذاك. فالواجب يعود إلى العقل. وهو معياره. غايته احترام القانون الأخلاقي بإرادة وحرية. " إننا لنجد بالنسبة للإنسان وكل الكائنات العاقلة أن الضرورة الأخلاقية لهي إكراه أي التزام. وكل فعل مؤسس عليها يجب أن نتمثله بوصفه واجبا ليس مجرد طريقة للفعل نرغب فيها الآن أو قد نرغب فيها مستقبلا على حد تعبير (إ. كانط). بعبارة أخرى ليس هنالك إلا أمر قطعي واحد يمكن أن تشتق منه كل الأوامر الأخلاقية المكونة للواجب : * ألا وهو التصرف وفق القاعدة التي تجعل قاعدة سلوكك قانونا كونيا شاملا. ومنه التصرف بطريقة تجعلك تعامل الإنسانية في شخصك كما في الأشخاص الآخرين كغاية وليس أبدا كمجرد وسيلة. وأخيرا تصرف بحيث يمكنك أن تعتبر نفسك بمثابة المشرع في مملكة الغايات التي تجعلها حرية الإرادة أمرا ممكنا. (كانط).من جهته يتنقد جون ماري غويو التصور الكانطي واصفا إياه بالصورية والتجريد والمثالية التي تقصي الأهواء وتنفي خصوبة الحياة " بواجب " هو أشبه ما يكون بالأمر العسكري. ويعتبر أن الواجب قدرة طبيعية يملكها كل فرد تدفعه إلى الفعل الأخلاقي – فهذا الشعور الداخلي يجعل من الواجب فيضا حيويا خارج كل ضغط أو إكراه. " إن الكائنات المنحطة التي تكون حياتها العقلية والطبيعية معوقة تكون الواجبات لديها قليلة، ذلك لأن قدراتها قليلة. أما الإنسان المتحضر فواجباته لا تحصى وما ذلك إلا لأن لديه نشاطا ثرا غنيا ينبغي إنفاقه على ألف صورة وصورة ."(ج.م. غوود).لكن يمكن للواجب أن يكون إلزاما وإكراها. وأن يكون محط رغبة وتبجيل ذلك أنه من المستحيل حسب اميل دوركايم، أن نسعى نفسيا واجتماعيا نحو تحقيق هدف نكون فاترين تجاهه ولا يبدو لنا خيرا ولا يحرك أريحيتنا فالواجب إلزام أخلاقي مرغوب فيه، يحقق لذة ما فهو أمر مستحسن لدينا. لذا نشعر دائما بتداخل الخير والواجب وتلازمهما. " إن الواجب، أي الأمر الأخلاقي الكنطي القطعي ليس إذن إلا مظهرا مجردا من مظاهر الواقع الأخلاقي. وهذا الوقع الأخلاقي يبين لنا أن هناك تآنيا مستمرا بين مظهرين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إذن لم يكن هناك أبدا فعل أخلاقي تم القيام به بشكل خالص على أنه واجب، بل يكون من الضروري دوما أن يظهر هذا الفعل على أنه جيد ومستحسن بشكل ما. وعلى العكس من ذلك يبدو أنه لا توجد موضوعات مرغوب فيها بشكل خالص، لأنها تتطلب دوما قدرا من المجهود الشخصي " (إ. دوركايم).وفي جميع الأحوال لابد من ربط الواجب الأخلاقي بالوعي الأخلاقي باعتباره مجموع الأحكام والأوامر والمعايير الأخلاقية. فما هو الوعي الأخلاقي؟ وما هو مصدره ؟.المحور الثاني: الوعي الأخلاقييمكن تعريف الوعي الأخلاقي أو الضمير الأخلاقي بتلك القدرة على إصدار أحكام معيارية على الأفعال الإنسانية وبالتالي فهذا الوعي هو الذي يضع معايير التمييز بين الرذيلة والفضيلة وبين الممنوع والمباح .. فمن أين ينبع هذا الوعي وما هو مصدره ؟ سبق لنا أن لمسنا أهمية العقل والإرادة والحرية كأسس للواجب الأخلاقي لدى كانط .. إلا أن روسو مثلا يعود بالضمير الأخلاقي الى الطبيعة الفطرية والغريزية في الإنسان والتي تدفعنا نحو الخير. هكذا " ففي أعماق النفوس البشرية يوجد مبدأ فطري للعدالة والفضيلة " تقوم عليه أحكامناا التي نصدرها على أفعالنا وأفعال الغير فنصنفها بالخيرة أو الشريرة، وإنني أسمي هذا المبدأ باسم الوعي (روسو) وعي يشبه الأحاسيس الباطنية، تلقائية وعفوية تضمن توافقنا مع الأشياء والأشخاص. أي توافق معاييرنا مع الواجب الأخلاقي.أما من الزاوية النفسية " فالضمير الأخلاقي " يغدو هو الأنا الأعلى باعتباره جزءا من البنية النفسية المحددة بالقيمة الاجتماعية، وليس كيانا قبليا مستقلا، إنه في الحقيقة الوظيفة التي ننسبها لهيأة الأنا الأعلى بجانب وظائف أخرى. وظيفة تمارس المراقبة على أفعال ومقاصد الأنا والحكم عليها. " فالإحساس بالذنب، وقساوة الأنا الأعلى، وصرامة الضمير الأخلاقي كلها شيء واحد." الإحساس بالذنب هو أثر المراقبة على الأنا أو الشعور ومدى توتر ميولاتها؛ وقساوة الأنا الأعلى تبدو في القلق النفسي المقلق للأنا؛ أما الشعور بالحاجة إلى العقاب فهو تعبير عن الدوافع العدوانية الكامنة في الأنا.نفس الموقف تقريبا؛ يعبر عنه فردريك نيتشه. فالوعي الأخلاقي إحساس تأسس على الطابع المأساوي الذي ميز علاقات الناس المنقسمين إلى سادة وعبيد. فضرورة تسديد الدين مثلا تعتبر واجبا والتزاما من طرف الدائن تجاه المدين. ويحق لهذا الأخير أن يعوض دينه بشيء آخر مما يملكه الدائن بما فيه جسده أو زوجته… أو حريته ... إن هذه التقديرات الشنيعة في دقتها هي التي تأخذ قوة القانون وتغدو سلطة للقوي على الضعيف العاجز – فأصل القيم الأخلاقية " كالخطأ " و " الضمير " و"الواجب" مستنبتة على هذه الأرض بدماء كثيرة ومأساوية فادحة. حتى الأمر المطلق الذي قال به كانط لا يخلو من قسوة. هي نفس القسوة التي يعكسها لنا الصراع الطبقي داخل المجتمع. لكن ما علاقة الواجب بالمجتمع ؟.المحور الثالث: الواجب والمجتمع:عبر مفهوم الصراع الطبقي يتشكل مفهوم الوعي حسب الماركسية ويتحدد بالتالي مفهوم الوعي الأخلاقي البروليتاري على الخصوص . " إن الظروف الاجتماعية هي التي تحدد وعي الناس وليس وعي الناس هو الذي يحدد ظروفهم الاجتماعية. " من هنا يصبح الواجب إكراها اجتماعيا، يتجاوز إرادة الأفراد وحريتهم.إن المصدر الوحيد للواجب الأخلاقي حسب إ. دوركايم هو المجتمع، الذي يبدو لنا في صوت مهيب يأمرنا باحترام الواجب. ومادام هذا الصوت أمرا فإننا نحس به صادرا عن كائن متعالي. ضخمه خيال الشعوب إلى أن بات كائنا علويا أسطوريا. فوراء هذا الرمز لا تكمن إلا حقيقة واحدة هي حقيقة المجتمع الذي أشرط كل سلوكاتنا بالواجب الجماعي المسند إلى الضمير الأخلاقي الاجتماعي. أما ماكس فيبر ... فيميز في الأخلاق بين نوعين : أخلاق الاعتقاد أو الضمير (عقدية عامة) وأخلاق المسؤولية وهي أخلاق مرتبطة بالمحاسبة والمسؤولية الفردية داخل المجتمع. الأولى تقليدية تعلق مسؤولية الفرد على مشيئة الله أو قوة إيديولوجيا والثانية حداثية قائمة على الوعي الأخلاقي الفردي ومحاسبته قانونا داخل المؤسسات الاجتماعية. ومادام المجتمع هو الذي يرسم للفرد مناهج حياته الفردية ويدفعه ليختار بصورة طبيعية ما هو موافق للقاعدة المبتغاة : فالواجب بهذا المعنى يكاد يتحقق آليا : حسب هـ. برغسون. إلا أنه لا يجب أن نحصر مفهوم المجتمع في بقعة الوطن الضيقة بل علينا أن نوسع منه حتى يشمل الإنسانية بكاملها فنتحدث عن الواجبات الإنسانية من حيث هي كذلك.وللاقتناع بهذا الأمر يجب استحضار حالة الحرب وما يسود فيها من قتل وسلب وغدر على المستوى الكوني الآن. فالواجب الأخلاقي الكوني بات أمرا ملحا مثله مثل التضامن بين الأجيال. إلا أن هذا التضامن يندرج ضمن واجبات المجتمعات الحالية تجاه المجتمعات القادمة، وفي النهاية فإنه عندما تترسخ وتستقر المؤسسات العادلة المقامة على أساس صلب، وعندما يتم إقرار الحريات الأساسية فعليا، فإن حجم التراكم يستقر، حينئذ يكون المجتمع قد أدى واجبه في العدالة بضمان المؤسسات وأساسها المادي والمبدأ العادل للتوفير يشير إلى ما يجب على مجتمع ما أن يوفره بطريقة عادلة. (جون راولس). لكن أليس الالتزام بالقانون الأخلاقي هو أساس السعادة ؟الحرية مقـدمة :رغم انتماء الإنسان لعالم الطبيعة، ورغم خضوعه لعدد لا يحصى من قوانينها، فهو مع ذلك يعتبر أكثر الكائنات قدرة على التخلص من حتمية تلك القوانين، و أقواها نزوعا نحو التحرر من ضرورات الطبيعة، فهو قد يمتنع عن الطعام رغم احتياجه للأكل، وقد يمتنع عن الجنس رغم حاجته إلى التوالد، بل قد يتجه نحو الموت رغم غريزة حب البقاء، وهو ما يعني أن ما يحكم أفعال الإنسان وتصرفاته ليس هو قوانين الطبيعة وحدها وليس حتميات الضرورة فقط ،بل شيء آخر، اعتدنا على أن نسميه الحرية، لكننا اعتدنا في الوقت نفسه على أن نختلف حول مدلولها، حول أبعادها وحدودها. فما معنى أن يكون الإنسان حرا: هل معناه أن يتصرف كما يريد وكما يحلو له، أي كما تقررإرادته فقط دون سواها، أم معناه أن يتصرف كما تقتضي ذلك القوانين والأخلاق العامة السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه؟ وهل كون الإنسان كائن حر معناه أنه قادر على تجاوز مختلف الحتميات الخارجية والداخلية، وتبعا لذلك فحريته هي حرية مطلقة، أم أن تلك الحتميات نفسها هي ما يحدد حريته، وتبعا لذلك فهذه الأخيرة تظل بالنسبة إليه محدودة ومقيدة؟ كيف يمكن للإنسان أن يوفق بين رغبته في أن يكون حرا وفي الوقت نفسه احترام رغبة الآخرين في ان يكونوا أحرارا أيضا؟ كيف يمكنه أن يوفق بين حريته الفردية وضرورة احترام القانون الذي هو الوحيد الكفيل بضمان تمتعه بها؟ I - الحرية و الحتمية :يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية بامتلاكه للعقل، أي بامتلاكه لملكة تجعله قادرا على التفكير والاستدلال، و على الحساب و التمييز. فإلى أي حد يمكنه تميزه هذا من الخروج عن نظام الحتمية والضرورة السائدتين في الطبيعة؟ بمعنى آخر هل كون الإنسان يمتلك العقل كفيل بجعل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفات ما هو إلا نتاج وحصيلة لإراداته و اختياراته، أم أن الإنسان، و على الرغم من امتلاكه للعقل، فأفعاله وتصرفاته تبقى مجرد نتاج لمقتضيات وإملاءات شروط وحتميات تقع خارج نطاق إرادته و اختياره، وتتجاوز مجال حسابات و استدلالات عقله؟لقد ظل الإنسان، ولمدة طويلة من الزمن، ينظر إلى حياته على أنها تنفيذ لمخططات أنجزتها سلفا قوى غيبية مفارقة مجسدة في الإله أو الآلهة. فهذا التصور لا يحضر فقط في الأديان، التي كانت ولازالت تعبر عنه بمفهوم 'القدر'، وإنما يحضر أيضا عند العديد من الفلاسفة من أبرزهم 'إبكتيت Epictète' و ابن رشد قديما، و 'سبينوزا Spinoza' وممثلوا العلوم الإنسانية حديثا. فبالنسبة لإبكتيت ليست الحياة في هذا العالم سوى مسرحية كبيرة مخرجها هو الله و مشخصوها هم أفراد النوع الإنساني الذين تمثل حياة كل فرد منهم دورا من أدوارها ما عليه إلا تأديته بإتقان، يقول 'إبكتيت': "تذكر دوما هذا الأمر، إنك مجرد ممثل على الخشبة لدور اختاره لك المخرج، دور قد يطول أو يقصر بحسب إرادته هو طويلا أو قصيرا. فإذا كان يريدك أن تقوم بدور المتسول، فيجب أن تلعب هذا الدور على الوجه الأكمل، و الشيء نفسه إذا كان يريدك أن تقوم بدور رجل أعرج أو رجل السياسة...، فعملك ينحصر في لعب الدور الذي حدد لك، أما الإخراج فلا تسأل، إنه من عمل غيرك."[1] و هكذا فالمتسول في رأي 'إبكتيت' لم يكن كذلك لأنه ارتأى، بناءا على حساباته و تقديراته العقلية، أن التسول هو أفضل السبل و أكثرها ملائمة لقدراته من أجل ضمان حياته و قوته اليومي، وإنما هو كذلك، أي متسولا، لأن المخرج الذي هو الله ارتأى أن تكون مسرحية الحياة الدنيا تتضمن متسولين، وحدد أشخاصا بعينهم لتمثيل هذا الدور فكان لزاما عليهم تأديته على الوجه الأكمل، وبدون أدنى تبرم أو شكوى. و نفس الأمر بالنسبة لباقي الأدوار الأخرى فهي جميعها محددة سلفا من قبل رب العالمين الذي اختار ومنذ الأزل من يقوم بأداء و تشخيص كل واحدة منها. وهو الموقف نفسه الدي نجده عند واحد من كبار الفلاسفة المسلمين وهو الفيلسوف المغربي أبي الوليد ابن رشد الذي اعتقد أن أفعال وتصرفات الأفراد مفروضة عليهم بقوانين الطبيعة وبقوى الجسد وهي كلها مخلوقة من قبل الله تعالى وما على الإنسان سوى الخضوع لمقتضياتها.أما بالنسبة ل'سبينوزا' فقد اعتبر أن أفعال وتصرفات الأفراد بكل تفاصيلها مفروضة عليهم بقوانين كلية وثابتة هي نفسها قوانين الكون والطبيعة. فعلى غرار قطعة الحجر التي لا تمتلك، بعد تلقيها الدفعة أو الحركة الأولى، الحرية في اختيار التوقف أو الاستمرار في الحركة وإنما تعمل على تنفيذ مقتضيات مبدأ العطالة، لا يمتلك الإنسان أدنى حرية في اختيار الأفعال التي ستصدر عنه بما في ذلك أبسطها كالكلام أو عدمه، و إشباع رغبة أو تأجيلها على سبيل المثال، يقول 'سبينوزا':" فقد أثبتت التجربة بما فيه الكفاية أن أقل ما يمكن للبشر التحكم فيه هو تحكمهم في ألسنتهم، وأنهم لا يقدرون على شيء أقل من التحكم في شهواتهم"[2] فكون الإنسان يمتلك العقل في رأي 'سبينوزا' لا يجعل منه كائنا أسمى من الطبيعة، ومخالفا في تصرفاته لمقتضيات قوانينها، وإنما يجعله فقط، وهذا ما يميزه عن باقي الموجودات الأخرى، يعي انتماءه إلى الطبيعة و يعي ما يصدر عنه من أفعال و تصرفات، ووعيه هذا هو ما يجعله يعتقد بأنه حر، وبأن كل ما يصدر عنه هو نتاج قرارات حرة اتخذها بمحض إرادته وبعيدا عن أي إكراه، غير أن اعتقاده هذا هو اعتقاد خاطئ في رأي هذا الفيلسوف، إنه ليس أكثر من حكم مسبق مبني على جهل مطبق بالأسباب الحقيقية المتحكمة في الأفعال و التصرفات، يقول 'سبينوزا': "إن الناس يظنون أنفسهم أحرارا لمجرد كونهم يعون أفعالهم و يجهلون الأسباب المتحكمة فيهم"[3] فكون الفرد يجهل تماما الأسباب و الدوافع الكامنة وراء تصرفاته، وفي الوقت نفسه وعيه بها، هو ما يجعله يعتقد بأن تلك التصرفات هي نتاج لأرادته الحرة، بينما هي ليست كذلك بالمطلق، والدليل على أنها ليست كذلك هو أن " التجربة تثبت أننا نندم على العديد من الأفعال التي تصدر عنا، وأننا غالبا ما ندرك الأفضل ونتبع الأسوأ."[4]إن هذا الإنكار لقدرة الإنسان على خلق أفعاله وعلى التصرف بمحض حريته واختياره سيتعمق أكثر مع ظهور ما يسمى بالعلوم الإنسانية، التي و إن كانت قد استبعدت من مجال الفعل الإنساني أي تدخل للقوى الغيبية المفارقة، فهي ستجعل من سلوكات الأفراد مجرد استجابات آلية و ميكانيكية لشروط وحتميات خارجة عن نطاق إرادتهم و حريتهم. فمع التحليل النفسي ، الذي ظهر مع الطبيب النمساوي 'سيغموند فرويد Freud'[5], ليست الميولات و المواقف التي توجد لدى شخص ما في لحظة زمنية ما، و التي تشكل مجتمعة ما يسمى شخصيته، سوى نتيجة حتمية لمجموع العقد و الأزمات النفسية التي تعرض لها في مرحلة سابقة وبصفة خاصة في مرحلة الطفولة. فالفرد الإنساني محكوم في رأي هذا العالم النفساني بثلاث قوى أساسية، ذات مطالب متناقضة، هي: الهو، الأنا، الأنا الأعلى. فالهو الذي يمثل الرغبات والغرائز يطالب الفرد بالإشباع و بتحقيق اللذة، بينما الأنا الذي يمثل الواقع فهو يطالبه بالامتثال لمقتضيات العالم الخارجي، أما الأنا الأعلى الذي يمثل القيم الأخلاقية والدينية فيطالبه باحترام قواعد معينة في سلوكه. وبحكم التناقض الحاصل بين مطالب هذه القوى الثلاث فإن التوفيق فيما بينها يبدو أمرا مستحيلا. غير أن هذا الأمر المستحيل هو بالضبط ما على الفرد القيام به إن أراد أن يضمن لنفسه حياة نفسية سوية،لأن التفريط في مطالب أي قوة من هذه القوى، أو تغليب إحداها على الأخرى، يولد لدى الفرد أزمات وعقد نفسية تظل تؤثر عليه طيلة حياته، وتطبع شخصيته المستقبلية بسمات و خصائص لا يدري هو نفسه مصدرها. وهذا هو واقع حال السواد الأعظم من أبناء الجنس البشري في رأي 'فرويد'،فهم كلهم، إلا فيما ندر، مرضى من الناحية النفسية، لأن لا أحد بإمكانه إشباع كل متطلبات الهو و في الوقت نفسه مراعاة مقتضيات الواقع من جهة، وإلزامات الأنا الأعلى من جهة ثانية. وهكذا فبداخل كل فرد هناك عقد نفسية هي التي تفرض عليه مواقف ونماذج للسلوك عليه أن يتبناها ويتصرف بمقتضاها. فحتى المواقف و السلوكات التي تبدو أنها من نتاج إرادتنا و اختياراتنا الحرة فهي ليست كذلك إلا في ظاهرها،أما في حقيقتها فهي ليست أكثر من نتيجة حتمية لتلك العقد النفسية التي نحملها و التي تولدت لدينا في الماضي بفعل فشلنا الحتمي في مهمة التوفيق بين مطالب كل من الهو، الأنا، الأنا الأعلى.أما مع علم الاجتماع فليست مواقف و ميولات الشخص في لحظة زمنية ما و التي تشكل مجتمعة شخصيته، سوى نتيجة حتمية للتأثيرات المختلفة التي مارسها عليه المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق التربية و التنشئة الاجتماعية[6]. أي أن شخصيتنا في رأي علماء الاجتماع ليس نحن هم الذين نختارها بمحض إرادتنا وبإمكاننا أن نغيرها متى شأنا، وإنما المجتمع هو الذي يحددها لنا و يفرضها علينا، وهو الذي يمكنه أن يفرض علينا في لحظة ما تغييرها أو إدخال تعديلات عليها، لأنه إذا كانت التربية هي المحدد الرئيسي لما سيكونه الطفل في المستقبل، فهذا الطفل ليس له أدنى دخل في اختيار نوعية وطريقة التربية التي سيتلقاها، بل المجتمع من أسرة و مدرسة و حي...الخ هو الذي يحدد كل ذلك، و تبعا لهذا فليس للفرد أدنى حرية في اختيار ما يكونه بل ما يكونه مفروض عليه قسرا.إن ما يجمع كل المواقف السابقة هو نفيها للحرية الإنسانية و لقدرة الفرد على تحديد و اختيار شخصيته و مصيره بنفسه، وهو ما عبرت عنه البنيوية بجملة واحدة هي "موت الإنسان"[7].وهو الموت الذي ستنهض ضده الفلسفة الوجودية بزعامة 'جان بول سارتر Sartre' الذي سيدافع وباستماتة، وضدا على كل التصورات السابقة، عن الحرية الإنسانية وعن قدرة الإنسان على صنع مصيره بنفسه. فالإنسان حسب هذا الفيلسوف هو "الكائن الوحيد الذي يسبق وجوده ماهيته"[8] أي أنه الكائن الوحيد الذي لا يتحدد وجوده انطلاقا من قوالب جاهزة ومعدة سلفا وإنما "يوجد أولا وبعد ذلك يختار ما سيكونه"[9] فالشروط والمحددات النفسية والاجتماعية والاقتصادية...الخ. ليست بالنسبة للإنسان سوى معطيات و مواد أولية لبناء مشاريع مستقبلية خاصة ومتفردة هي التي تحدد مصيره. وتبعا لذلك فتصرفات الأفراد و مواقفهم لا تعبر عن استجابات ميكانيكية و آلية لتلك الشروط و المحددات، وإنما تعبر عن حريتهم وقدرتهم الإبداعية، التي تتمثل في إضافة معاني جديدة وشخصية لتلك الشروط و المحددات، بمقتضاها تصبح حياة كل فرد عبارة عن مشروع ذاتي خاص و متميز "فالإنسان - يقول سارتر- ليس شيئا آخر غير ما هو صانع بنفسه، إنه لا يكون إلا بحسب ما ينويه وما يشرع في فعله"[10] لا بمعنى أن الشروط الموضوعية القائمة ليس لها تأثير على ما سيكونه الفرد بحيث يمكن إلغاؤها و نفيها كليا، وإنما بمعنى أن الإنسان قادر على التصرف وبحرية تامة انطلاقا من الإمكانات التي تتيحها تلك الشروط، فهذه الأخيرة لا تفرض مسارا واحدا بعينه، وإنما تنفتح على مسارات و إمكانات متعددة، و الفرد نفسه هو الذي يختار منها ما يراه ملائما. فإذا كانت نفس الأسباب، في مجال الوجود الفيزيائي، تفرض و تؤدي حتما إلى نفس النتيجة، ففي مجال الوجود الإنساني ليس الأمر كذلك، إذ تؤدي نفس الأسباب إلى نتائج متباينة بل ومتناقضة. فمهما تشابهت المؤثرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية..الخ، التي يمكن أن يتعرض لها مجموعة من أفراد النوع الإنساني، فإن ذلك لن ينتج عنه أبدا وجود تشابه في شخصياتهم المستقبلية، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرض عليهم نفس المصير، وفي هذا دليل قاطع على أن ما يحكم الوجود الإنساني ليس هو قانون العلية وإنما هو قانون الحرية.نفس هدا الموقف نجده عند الفيلسوف الفرنسي المعاصر "موريس ميرلوبونتي" فقد اعتقد هو الآخر أن الحرية هي صميم الوجود الإنساني، فكون الإنسان يمتلك الوعي يجعله برأيه قادرا على الإفلات من كل قيد أو حد، وذلك بمجرد التفكير في هذا القيد أو هذا الحد. لأن الوعي أو الشعور- كما يقول – هو بطبيعته انفصال ومفارقة وحرية، أي أنه ينطوي في صميمه على قدرة مستمرة على الانفصال عن الواقع،وعلى التحرر من شتى الحدود والقيود.واضح مما سبق أن الإنسان وإن كان حرا فحريته تلك تظل نسبية ومحدودة، إنها حرية مشروطة بالمعطيات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتمتع بها كل فرد، وبالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه .المحور الثاني: حرية الإرادةتعتبر الإرادة محددا رئيسيا للعديد من الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الإنسان ، بل هي السبب النهائي والوحيد الدي يمكن من خلاله تفسير لماذا أقدم هذا الفرد أو ذاك على هذا العمل دون سواه، ولماذا تبنى هذا الاختيار دون غيره، إلى حد يمكن معه القول أنه إذا كان الإنسان كائن حر فمصدر حريته تلك هي الإرادة الحرة التي يمتلكها، لكن هل الإرادة التي يمتلكها الإنسان فعلا حرة؟ وإدا كانت كدلك فهل حريتها تلك هي حرية مطلقة أم نسبية؟ وهل تسيطر إرادتنا على كل أفعالنا أم على بعضها فقط؟ ماهي مجالات الفعل الإنساني التي يمكن اعتبارها خاضعة لإرادته وما هي تلك التي يمكن اعتبارها تقع خارج نطاق مملكة الإرادة البشرية؟لقد ميز الفيلسوف المغربي الشهير " أبو بكر ابن باجة" في أفعال الإنسان بين نوعين: أفعال يختارها عن إرادة (الإرادة الكائنة عن روية)، وهي وحدها التي تستحق أن تسمى أفعالا إنسانية في رأيه، لأنها خاضعة للفكر، محددة بما يوجد في النفس من رأي أو اعتقاد، ويسبقها تدبير وترتيب، وأفعال لا يختارها عن إرادة، وإنما تفرض عليه بالانفعالات التي تتقدمها في النفس، وهذه لا تستحق أن تسمى أفعالا إنسانية وإنما أفعالا بهيمية فقط، لأنها مجرد ردود أفعال آلية ، ميكانيكية، خالية من كل تدبير مسبق، وغير مؤسسة على تفكير قبلي؛ وهكذا فكسر إنسان لعود خدشه لمجرد أنه خدشه، يعتبر فعلا بهيميا، لأنه مجرد رد فعل انفعالي على ما أصابه، أما كسره لئلا يخدش غيره، فهو فعل إنساني لأنه محدد بتفكير وروية. إن تميز ابن باجة هذا بين الأفعال الإرادية وتلك التي ليست كذلك وإن كان لا يبين لنا باضبط مجالات اشتغال الأرادة الأنسانية، فهو يبين بشكل واضح أن الإرادة هي ما يجعل فعلا ما فعلا إنسانيا، فكل فعل يصدر عن الإنسان غير محدد بإرادة فهو لا يستحق ان يسمى فعلا إنسانيا وإنما هو فعل بهيمي فقط، وهو ما يعطي للإرادة قيمة سامية ويرفعها إلى مصاف الملكات الشريفة التي يمتلكها الإنسان والتي يمثل اتباع أوامرها شرط ضروري للارتقاء في سلم مراتب الوجود ليصبح أكثر أكثر قربا من مرتبة الألوهية، و وأكثر بعدا من مرتبة البهيمة.لقد ظلت الإرادة تحتفظ بنفس القيمة التي حددها لها ابن باجة منذ القرن لدى العديد من الفلاسفة سواء في الفترة الحديثة أو في الفترة المعاصرة، ففي الفترة الحديثة دافع كل من ديكارت وكانط عن أهمية الإرادة في مجال الفعل الإنساني مع اختلاف أساسي بينهما وهو أن الأول أي ديكارت ربطها بمجال المعرفة بينما الثاني أي كانط ربطها بمجال الأخلاق. فحسب ديكارت المعرفة هي المجال الحقيقي الذي تستطيع فيه الإرادة الحرة أن تشتغل و تصدر أحكامها، بل أن ما يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ في رأي ديكارت هو حرية الإرادة التي يمتلكها وقدرته على حسن استعمالها ، وهكذا، كما يقول ديكارت في كتابه "تأملات ميتافيزيقية": "الأحكام التي نصدرها عن الأشياء ،تكون معقولة كلما كانت الإرادة حرة ". أما حسب كانط فالمجال الوحيد الذي يمكن التكلم فيه عن إرادة حرة هو مجال الأخلاق ،حيث يقول في كتابه " أسس ميتافيزيقيا الأخلاق: "إن الإنسان بوصفه كائنا عاقلا يستطيع اعتمادا على إرادته الحرة ، وضع القواعد العقلية للعقل الإنساني و الخضوع لهذه القواعد" وهو ما يعني أن الإرادة الحرة للإنسان ستصبح مع إيمانويل كانط، المبدأ الأسمى للأخلاق، لأنها، من جهة، تمثل مصدر الأمر الأخلاقي المطلق الذي يصلح لكل إنسان وفي كل زمان ومكان، ومن جهة ثانية، ستزيل كل تعار ض ممكن بين الحرية و الواجب على اعتبار أن خضوعنا لإرادتنا الحرة واحترامنا للواجبات والقوانين الأخلاقية هما في نهاية التحليل شيء واحد، لأن مصدرهما واحد هو ذاك الذي اتخذ منذ كانط إسم "سلطان اإرادة".أما في الفلسفة المعاصرة فقد رفض كل من الفيلسوف الفرنسي " جان بول سارتر" والفيلسوف الأمريكي "أليكسيس توكفيل" أي تقييد للإرادة ، وأي تحديد لمجالات اشتغالها فحسب "توكفيل" بقدر ما عند الإنسان من إرادة بقدر ما عنده من حرية " حيث يوضح في كتابه – الديمقراطية في أمريكا – أن الإرادة الحرة لدى الفرد وحدها التي تبعده عن العبودية و تضمن له التمتع بحريته السياسية والآجتماعية والآقتصادية. . . الخ، فكل هذه الأشكال من الحرية التي يمكن للفرد أن يتمتع بها أصلها واحد ومصدرها واحد وهو حرية الإرادة التي يمتلكها والتي تتسع حريته بقدر اتساعها على حد تعبيره. أما حسب "سارتر" فالحرية هي نسيج الوجود الإنساني بأكمله، حيث يقول معبرا بوضوح عن هذا المعنى: "إن الإنسان حر، الإنسان حرية... الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا، محكوم عليه لأنه لم يخلق نفسه وهو مع ذلك حر لأنه متى ألقي به في العالم، فإنه يكون مسؤولا عن كل ما يفعله"، وهكذا بدون الحرية لن يكون الإنسان إنسانا أصلا ، بدون الحرية سيموت الإنسان، لأن هذه الأخيرة ليست مجرد شيء عرضي أو زائد في الوجود الأنساني بل هي الما هية الوحيدة المحددة لهذا الوجود، أو لنقل مع سارتر إنها الوجود الإنساني نفسه حيث بانتفائها سينتفي هو نفسه وسيصبح مجرد وجود طبيعي أو فيزيائي وليس أبدا وجودا إنسانيا.رغم هذا التقديس الذي تمتعت به الإرادة، ورغم تلك القيمة السامية التي منحها لها الفلاسفة على امتداد تاريخ الفلسفة، فإن هذا الأخير لا يخلو من بعض الآراء والتصورات الفلسفية التي ستبعد مجال اشتغال الإرادة الحرة، ليس من المعرفة فقط، وإنما من الأخلاق أيضا، ليتم ربطها بما هو حيواني في الإنسان أي بالغرائز والنموذج البارز الذي دافع عن هذا التصور هو الفيلسوف الألماني "فريدريك نيتشه" الذي جاءت أفكاره معادية تماما لأفكار كل من ديكارت (الذي ركز على المعرفة وربط الإرادة بها) و كانط (الذي ركز على الأخلاق التي ربطها بسلطان الإرادة)، فحسب نيتشه ليس هناك أي مبرر أدى إلى الإعلاء من قيمة العقل ومن قيمة الأخلاق سوى أنهما أثبتا نجاعتهما في معركة الصراع من أجل البقاء وتبعا لذلك فهما معا ليس سوى تابعين لإرادة أقوى هي ما يسميه "إرادة الحياة"، ومن ثمة فإن اتباعهما لا يؤدي إلا إلى التعلق بأوهام تقدم ذاتها في صورة قيم و مثل عليا مفارقة، تتخذها كأقنعة و كمبررات يعلن باسمها الجهاد ضد الحياة، و الحرب ضد الوجود، الشيء الذي يؤدي إلى انتصار ما يسميه نيتشه ب"القوى الارتكاسية" في الإنسان، بدل انتصار "القوى الفاعلة" فيه، فالإرادة التي دافع عنها كانط وأعلى من شأنها هي في رأي نيتشه "إرادة إنكارية" لأنها تقوم على تبخيس الحياة، وذلك في مقابل إرادة أخرى يدافع عنها هو، و يسميها " إرادة توكيدية" وهي إرادة تقوم على تمجيد الحياة والإعلاء من شأنها، الأولى تعبر عن حياة مرضية أصابها الوهن و الضعف و الإعياء، ولم تعد قادرة على مواجهة تناقضات الحياة ومفارقاتها، فضلا عن آلامها وشرورها،بينما تعبر الثانيةعن حياة قوية و سليمة، تتمتع بصحة جيدة، قادرة على الانفتاح على الحياة وعلى توكيدها بكل تناقضاتها ومفارقاتها وبكل شرورها وأحزانها، وهكذا فإن الإرادة الحرة التي دافع عنها كانط هي إرادة الضعيف، بينما التي ينادي بها نيتشه، ويدافع عنها، هي إرادة القوي أو ما سماه نيتشه بالضبط "إرادة القوة" .بغض النظر عن الاختلافات السابقة بين مواقف الفلاسفة من الإرادة ومجالات اشتغالها فالأمر اليقيني والمؤكد والذي لا يمكن الاختلاف فيه هو أن الإرادة هي المصدر الرئيسي إن لم يكن الوحيد لحرية الإنسان ولقدرته على التحرر من شتى القيود التي تفرض عليه من كافة النواحي. المحور الثالث:الحرية والقانونتقترن الحرية بكل تأكيد بالإرادة الحرة للفرد وبقدرته على فعل كل ما يريد بعيدا عن أي ضغط أو إكراه، لكن إذا فعل كل شخص كل ما يريده ألا يمكن لذلك أن يؤدي إلى فوضى؟ ألا يمكن أن تتعارض إرادة فرد مع إرادة فرد آخر أو أفراد آخرين، فتؤدي حريتهما تلك إلى تقاتلهما، و تبعا لذلك شقائهما، بدل أمنهما وسعادتهما؟ أليس من الضروري، كي يتمتع الأفراد حقيقة بحريتهم، وجود قوانين تنظم تلك الحرية نفسها؟ لكن من جهة ثانية ألا يؤدي تقنين أفعال وتصرفات الأفراد بقوانين وإرغامهم على عدم تجاوزها نفي لحريتهم، أم أن الأمر عكس ذلك بحيث وجود مثل تلك القوانين شرط ضروري لوجود الحرية ولتمتع الأفراد بها؟إن انتماء الإنسان إلى عالم الطبيعة و تموقعه كجزء لا يتجزأ منها جعل العديد من الفلاسفة يعتقدون بأن قوانين الطبيعة يجب أن تكون هي المعيار والنموذج الموجه لكل سلوكاتنا وأفعالنا، وأن حرية الأفراد، شأنها في ذلك شأن حرية باقي الكائنات الأخرى يجب أن تتحدد من خلال نظام الطبيعة وقوانينها، لأنها وحدها ثابتة و مطلقة، وهكذا سيؤكد جل الفلاسفة والمفكرين السياسيين خلال القرنين 17و18مثل توماس هوبز، جون جاك روسو، جون لوك، باروخ سبينوزا...الخ على أن حرية كل كائن تتحدد من خلال الخصائص التي زودته الطبيعة بها، و التي تحدد نمط وجوده وحياته: فإذا كانت الطبيعة زودت السمك بخاصية السباحة وأكل كبيره لصغيره، فإن ذلك يجعل من سباحة السمك في الماء، وأكل كبيره صغيره، من صميم حريته، و الأمر نفسه ينطبق على الإنسان أيضا، فما دامت الطبيعة زودت كل فرد برغبات وقدرات وغرائز خاصة، فإن حريته في رأي هؤلاء الفلاسفة تتحدد من خلال ذلك، أي أن كل ما يقدر عليه الفرد ويرغب فيه فهو حر في أن يتجه إليه ويعمل على تحقيقه ،وبذلك يكون الإنسان وفق قوانين الطبيعية يمتلك حرية مطلقة في القيام بكل ما يشتهيه ويقدر عليه.غير أن عيش الإنسان وفق هذه الحرية الطبيعية، وإن كان يجعل حريته تلك حرية مطلقة فذلك لا يستطيع أن يضمن له حياة سعيدة وآمنة ، بل إن العيش وفق هذه الحرية يؤدي إلى "شقاء عظيم" كما يقول سبينوزا،وإلى حرب الكل "ضد الكل " كما يقول توماس هوبز،حيث غياب الأمن والاستقرار، وسيادة العنف والفوضى. ونظرا لكون الإنسان ميال بطبعه للأمن والاستقرار، فقد كان لزاما عليه الانتقال من العيش وفق الحرية الطبيعية التي تتحدد من خلال الرغبة والقدرة، إلى العيش وفق الحرية المدنية و الثقافية التي تحدد من خلال قوانين يتم التعاقد والاتفاق حولها. وهكذا ستصبح الحرية كما يعرفها مونتيسيكيو هي : " أن يقدر المرء على أن يعمل ما ينبغي عليه أن يريد، وألا يكره على عمل ما لا ينبغي أن يريد"، أي الحق في أن يعمل المرء ما تجيزه القوانين العادلة فقط، وليس كل ما يرغب فيه ويقدر عليه، لأن بدون ذلك، ستنتفي الحرية وتتلاشى. وهكذا ستصبح الحرية مع مونتسكيو مرتبطة بالقانون ومحددة به بالقانون، وهو الربط نفسه الذي سيسير به روسو بعيدا إلى الأمام. فما دام المصدر الوحيد للقوانين هو إرادة أفراد الشعب أنفسهم فإن خضوعهم لتلك القوانين لا ينطوي على أ إلزام أو إكراه وتبعا لذلك فهو لا يتعارض مع تمتعهم بحريتهم، وهكذا فإن انتقال الإنسان من العيش وفق حريته الطبيعية المحددة بقدراته ورغباته، إلى العيش وفق حرية مدنية محددة بقوانين وضوابط متعاقد حولها،لا يعني تقييدا لحريته أو إلغاء لحقوقه الطبيعية، وإنما يعني فقط تنظيم لهذه الحرية ولتلك الحقوق بحيث يصبح بالإمكان الاستفادة منها وممارستها بعيدا عن كل خوف أو تهديد.واضح إذن أن الأصل في كل حرية هي الطبيعة نفسها، غير ضمان الاستمتاع بشكل كامل بها ، و مهما كان، يقتضى بالضرورة إخضاعها لقواعد تنظمها وتقنن ممارستها.نفس الصفحة[/size] | |
|
abdo2.mohrach
إدارة الموقع


عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
 |  موضوع: رد: مجزوءة الاخلاق من اعداد الفريق التربوي بفاس موضوع: رد: مجزوءة الاخلاق من اعداد الفريق التربوي بفاس  الثلاثاء أبريل 14, 2020 8:59 am الثلاثاء أبريل 14, 2020 8:59 am | |
| - abdo2.mohrach كتب:
الواجــب
الواجب والقانون والحرية والمعاملات والحقوق والسلوك والضمير كلها مفاهيم تندرج ضمن الأخلاق، لكن يجب التمييز بين الأخلاق (Morale) والإتيقا (ethique). الأولى مبحث نظري من المباحث الكبرى للفلسفة؛ يمتاز بكونه علما معياريا؛ يهتم بتحديد القيم العليا الموجهة للفعل الإنساني ورسم معايير هذا الفعل وغاياته المقصودة. أما الإتقيا فهي " فلسفة الأخلاق " بحيث أنها لا تسائل القيم والمعايير والغايات في حد ذاتها بقدر ما تسائل التصورات الفلسفية المشيدة على تلك القيم الإنسانية. بعد هذا التمييز الأساسي لابد أن نتساءل عن معنى الواجب وعلاقته بالحقوق ؟ أهو إلزام وإكراه أم التزام وحرية ؟ ونتساءل عن دور المؤسسات الاجتماعية المختلفة في ترسيخ مفهوم الواجب وتركيزه وتوجيه تصرفات الفرد وفق قيم يعتقد فيها وهو مقتنع بها لكن ما هو الوعي الأخلاقي أهو التزام عقلي أم ميل طبيعي ؟ وما هي القيمة ؟ وما هو المعيار الملائم لوعيها ووعي قيمتها وأهميتها ؟
يمكن تركيب هذه التساؤلات وتجميعها في المحاور الثلاثة التالية :
1- الواجب بين الإلزام والالتزام.
2- الوعي الأخلاقي.
3- الواجب والمجتمع.
المحور الأول : الواجب بين الإلزام والالتزام.
يبدو أن مفهوم الواجب " هو من المفاهيم الأخلاقية الحديثة فهو يشكل المقولة الأساسية والوحيدة للأخلاق .. حسب إريك فايل ". ذلك أن فلسفات الأخلاق القديمة كما نعثر عليها في الفلسفة اليونانية قد ركزت اهتماماتها على مفهومي " الفضيلة " و" السعادة " (راجع الأخلاق إلى نيكوماخوس لأرسطو مثلا) أو على مفهومي " اللذة " و" المنفعة " (انظر أخلاقيات الأبيقورية والرواقية).
والواجب تحديدا " أمر أخلاقي " ملزم لكل الناس، إلا أنه أمر إشكالي فهل هو واجب قطعي يعبر عن قانون العقل وندائه ؟ أم هو استجابة لميل ونزوع الأهواء ؟
إن اختلاف الفلاسفة بهذا الصدد تحكمه حجج وحيثيات عدة ومتضاربة يمكن صياغتها كما يلي:
الإنسان جسد وعقل، يعني ضمير وأهواء . وفي خضم هذا الصراع وهذه التجربة ينبثق المبدأ العقلي للواجب الذي يهيمن ويفرض أوامره على الإنسان بشكل إلزامي وإكراهي فيلزمه بممارسة هذا السلوك أو ذاك. فالواجب يعود إلى العقل. وهو معياره. غايته احترام القانون الأخلاقي بإرادة وحرية. " إننا لنجد بالنسبة للإنسان وكل الكائنات العاقلة أن الضرورة الأخلاقية لهي إكراه أي التزام. وكل فعل مؤسس عليها يجب أن نتمثله بوصفه واجبا ليس مجرد طريقة للفعل نرغب فيها الآن أو قد نرغب فيها مستقبلا على حد تعبير (إ. كانط). بعبارة أخرى ليس هنالك إلا أمر قطعي واحد يمكن أن تشتق منه كل الأوامر الأخلاقية المكونة للواجب : * ألا وهو التصرف وفق القاعدة التي تجعل قاعدة سلوكك قانونا كونيا شاملا. ومنه التصرف بطريقة تجعلك تعامل الإنسانية في شخصك كما في الأشخاص الآخرين كغاية وليس أبدا كمجرد وسيلة. وأخيرا تصرف بحيث يمكنك أن تعتبر نفسك بمثابة المشرع في مملكة الغايات التي تجعلها حرية الإرادة أمرا ممكنا. (كانط).
من جهته يتنقد جون ماري غويو التصور الكانطي واصفا إياه بالصورية والتجريد والمثالية التي تقصي الأهواء وتنفي خصوبة الحياة " بواجب " هو أشبه ما يكون بالأمر العسكري. ويعتبر أن الواجب قدرة طبيعية يملكها كل فرد تدفعه إلى الفعل الأخلاقي – فهذا الشعور الداخلي يجعل من الواجب فيضا حيويا خارج كل ضغط أو إكراه. " إن الكائنات المنحطة التي تكون حياتها العقلية والطبيعية معوقة تكون الواجبات لديها قليلة، ذلك لأن قدراتها قليلة. أما الإنسان المتحضر فواجباته لا تحصى وما ذلك إلا لأن لديه نشاطا ثرا غنيا ينبغي إنفاقه على ألف صورة وصورة ."(ج.م. غوود).
لكن يمكن للواجب أن يكون إلزاما وإكراها. وأن يكون محط رغبة وتبجيل ذلك أنه من المستحيل حسب اميل دوركايم، أن نسعى نفسيا واجتماعيا نحو تحقيق هدف نكون فاترين تجاهه ولا يبدو لنا خيرا ولا يحرك أريحيتنا فالواجب إلزام أخلاقي مرغوب فيه، يحقق لذة ما فهو أمر مستحسن لدينا. لذا نشعر دائما بتداخل الخير والواجب وتلازمهما. " إن الواجب، أي الأمر الأخلاقي الكنطي القطعي ليس إذن إلا مظهرا مجردا من مظاهر الواقع الأخلاقي. وهذا الوقع الأخلاقي يبين لنا أن هناك تآنيا مستمرا بين مظهرين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. إذن لم يكن هناك أبدا فعل أخلاقي تم القيام به بشكل خالص على أنه واجب، بل يكون من الضروري دوما أن يظهر هذا الفعل على أنه جيد ومستحسن بشكل ما. وعلى العكس من ذلك يبدو أنه لا توجد موضوعات مرغوب فيها بشكل خالص، لأنها تتطلب دوما قدرا من المجهود الشخصي " (إ. دوركايم).
وفي جميع الأحوال لابد من ربط الواجب الأخلاقي بالوعي الأخلاقي باعتباره مجموع الأحكام والأوامر والمعايير الأخلاقية. فما هو الوعي الأخلاقي؟ وما هو مصدره ؟.
المحور الثاني: الوعي الأخلاقي
يمكن تعريف الوعي الأخلاقي أو الضمير الأخلاقي بتلك القدرة على إصدار أحكام معيارية على الأفعال الإنسانية وبالتالي فهذا الوعي هو الذي يضع معايير التمييز بين الرذيلة والفضيلة وبين الممنوع والمباح .. فمن أين ينبع هذا الوعي وما هو مصدره ؟ سبق لنا أن لمسنا أهمية العقل والإرادة والحرية كأسس للواجب الأخلاقي لدى كانط .. إلا أن روسو مثلا يعود بالضمير الأخلاقي الى الطبيعة الفطرية والغريزية في الإنسان والتي تدفعنا نحو الخير. هكذا " ففي أعماق النفوس البشرية يوجد مبدأ فطري للعدالة والفضيلة " تقوم عليه أحكامناا التي نصدرها على أفعالنا وأفعال الغير فنصنفها بالخيرة أو الشريرة، وإنني أسمي هذا المبدأ باسم الوعي (روسو) وعي يشبه الأحاسيس الباطنية، تلقائية وعفوية تضمن توافقنا مع الأشياء والأشخاص. أي توافق معاييرنا مع الواجب الأخلاقي.
أما من الزاوية النفسية " فالضمير الأخلاقي " يغدو هو الأنا الأعلى باعتباره جزءا من البنية النفسية المحددة بالقيمة الاجتماعية، وليس كيانا قبليا مستقلا، إنه في الحقيقة الوظيفة التي ننسبها لهيأة الأنا الأعلى بجانب وظائف أخرى. وظيفة تمارس المراقبة على أفعال ومقاصد الأنا والحكم عليها. " فالإحساس بالذنب، وقساوة الأنا الأعلى، وصرامة الضمير الأخلاقي كلها شيء واحد." الإحساس بالذنب هو أثر المراقبة على الأنا أو الشعور ومدى توتر ميولاتها؛ وقساوة الأنا الأعلى تبدو في القلق النفسي المقلق للأنا؛ أما الشعور بالحاجة إلى العقاب فهو تعبير عن الدوافع العدوانية الكامنة في الأنا.
نفس الموقف تقريبا؛ يعبر عنه فردريك نيتشه. فالوعي الأخلاقي إحساس تأسس على الطابع المأساوي الذي ميز علاقات الناس المنقسمين إلى سادة وعبيد. فضرورة تسديد الدين مثلا تعتبر واجبا والتزاما من طرف الدائن تجاه المدين. ويحق لهذا الأخير أن يعوض دينه بشيء آخر مما يملكه الدائن بما فيه جسده أو زوجته… أو حريته ... إن هذه التقديرات الشنيعة في دقتها هي التي تأخذ قوة القانون وتغدو سلطة للقوي على الضعيف العاجز – فأصل القيم الأخلاقية " كالخطأ " و " الضمير " و"الواجب" مستنبتة على هذه الأرض بدماء كثيرة ومأساوية فادحة. حتى الأمر المطلق الذي قال به كانط لا يخلو من قسوة. هي نفس القسوة التي يعكسها لنا الصراع الطبقي داخل المجتمع. لكن ما علاقة الواجب بالمجتمع ؟.
المحور الثالث: الواجب والمجتمع:
عبر مفهوم الصراع الطبقي يتشكل مفهوم الوعي حسب الماركسية ويتحدد بالتالي مفهوم الوعي الأخلاقي البروليتاري على الخصوص . " إن الظروف الاجتماعية هي التي تحدد وعي الناس وليس وعي الناس هو الذي يحدد ظروفهم الاجتماعية. " من هنا يصبح الواجب إكراها اجتماعيا، يتجاوز إرادة الأفراد وحريتهم.
إن المصدر الوحيد للواجب الأخلاقي حسب إ. دوركايم هو المجتمع، الذي يبدو لنا في صوت مهيب يأمرنا باحترام الواجب. ومادام هذا الصوت أمرا فإننا نحس به صادرا عن كائن متعالي. ضخمه خيال الشعوب إلى أن بات كائنا علويا أسطوريا. فوراء هذا الرمز لا تكمن إلا حقيقة واحدة هي حقيقة المجتمع الذي أشرط كل سلوكاتنا بالواجب الجماعي المسند إلى الضمير الأخلاقي الاجتماعي. أما ماكس فيبر ... فيميز في الأخلاق بين نوعين : أخلاق الاعتقاد أو الضمير (عقدية عامة) وأخلاق المسؤولية وهي أخلاق مرتبطة بالمحاسبة والمسؤولية الفردية داخل المجتمع. الأولى تقليدية تعلق مسؤولية الفرد على مشيئة الله أو قوة إيديولوجيا والثانية حداثية قائمة على الوعي الأخلاقي الفردي ومحاسبته قانونا داخل المؤسسات الاجتماعية. ومادام المجتمع هو الذي يرسم للفرد مناهج حياته الفردية ويدفعه ليختار بصورة طبيعية ما هو موافق للقاعدة المبتغاة : فالواجب بهذا المعنى يكاد يتحقق آليا : حسب هـ. برغسون. إلا أنه لا يجب أن نحصر مفهوم المجتمع في بقعة الوطن الضيقة بل علينا أن نوسع منه حتى يشمل الإنسانية بكاملها فنتحدث عن الواجبات الإنسانية من حيث هي كذلك.
وللاقتناع بهذا الأمر يجب استحضار حالة الحرب وما يسود فيها من قتل وسلب وغدر على المستوى الكوني الآن. فالواجب الأخلاقي الكوني بات أمرا ملحا مثله مثل التضامن بين الأجيال. إلا أن هذا التضامن يندرج ضمن واجبات المجتمعات الحالية تجاه المجتمعات القادمة، وفي النهاية فإنه عندما تترسخ وتستقر المؤسسات العادلة المقامة على أساس صلب، وعندما يتم إقرار الحريات الأساسية فعليا، فإن حجم التراكم يستقر، حينئذ يكون المجتمع قد أدى واجبه في العدالة بضمان المؤسسات وأساسها المادي والمبدأ العادل للتوفير يشير إلى ما يجب على مجتمع ما أن يوفره بطريقة عادلة. (جون راولس).
لكن أليس الالتزام بالقانون الأخلاقي هو أساس السعادة ؟
الحرية
مقـدمة :
رغم انتماء الإنسان لعالم الطبيعة، ورغم خضوعه لعدد لا يحصى من قوانينها، فهو مع ذلك يعتبر أكثر الكائنات قدرة على التخلص من حتمية تلك القوانين، و أقواها نزوعا نحو التحرر من ضرورات الطبيعة، فهو قد يمتنع عن الطعام رغم احتياجه للأكل، وقد يمتنع عن الجنس رغم حاجته إلى التوالد، بل قد يتجه نحو الموت رغم غريزة حب البقاء، وهو ما يعني أن ما يحكم أفعال الإنسان وتصرفاته ليس هو قوانين الطبيعة وحدها وليس حتميات الضرورة فقط ،بل شيء آخر، اعتدنا على أن نسميه الحرية، لكننا اعتدنا في الوقت نفسه على أن نختلف حول مدلولها، حول أبعادها وحدودها. فما معنى أن يكون الإنسان حرا: هل معناه أن يتصرف كما يريد وكما يحلو له، أي كما تقررإرادته فقط دون سواها، أم معناه أن يتصرف كما تقتضي ذلك القوانين والأخلاق العامة السائدة في المجتمع الذي يعيش فيه؟ وهل كون الإنسان كائن حر معناه أنه قادر على تجاوز مختلف الحتميات الخارجية والداخلية، وتبعا لذلك فحريته هي حرية مطلقة، أم أن تلك الحتميات نفسها هي ما يحدد حريته، وتبعا لذلك فهذه الأخيرة تظل بالنسبة إليه محدودة ومقيدة؟ كيف يمكن للإنسان أن يوفق بين رغبته في أن يكون حرا وفي الوقت نفسه احترام رغبة الآخرين في ان يكونوا أحرارا أيضا؟ كيف يمكنه أن يوفق بين حريته الفردية وضرورة احترام القانون الذي هو الوحيد الكفيل بضمان تمتعه بها؟
I - الحرية و الحتمية :
يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية بامتلاكه للعقل، أي بامتلاكه لملكة تجعله قادرا على التفكير والاستدلال، و على الحساب و التمييز. فإلى أي حد يمكنه تميزه هذا من الخروج عن نظام الحتمية والضرورة السائدتين في الطبيعة؟ بمعنى آخر هل كون الإنسان يمتلك العقل كفيل بجعل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفات ما هو إلا نتاج وحصيلة لإراداته و اختياراته، أم أن الإنسان، و على الرغم من امتلاكه للعقل، فأفعاله وتصرفاته تبقى مجرد نتاج لمقتضيات وإملاءات شروط وحتميات تقع خارج نطاق إرادته و اختياره، وتتجاوز مجال حسابات و استدلالات عقله؟
لقد ظل الإنسان، ولمدة طويلة من الزمن، ينظر إلى حياته على أنها تنفيذ لمخططات أنجزتها سلفا قوى غيبية مفارقة مجسدة في الإله أو الآلهة. فهذا التصور لا يحضر فقط في الأديان، التي كانت ولازالت تعبر عنه بمفهوم 'القدر'، وإنما يحضر أيضا عند العديد من الفلاسفة من أبرزهم 'إبكتيت Epictète' و ابن رشد قديما، و 'سبينوزا Spinoza' وممثلوا العلوم الإنسانية حديثا. فبالنسبة لإبكتيت ليست الحياة في هذا العالم سوى مسرحية كبيرة مخرجها هو الله و مشخصوها هم أفراد النوع الإنساني الذين تمثل حياة كل فرد منهم دورا من أدوارها ما عليه إلا تأديته بإتقان، يقول 'إبكتيت': "تذكر دوما هذا الأمر، إنك مجرد ممثل على الخشبة لدور اختاره لك المخرج، دور قد يطول أو يقصر بحسب إرادته هو طويلا أو قصيرا. فإذا كان يريدك أن تقوم بدور المتسول، فيجب أن تلعب هذا الدور على الوجه الأكمل، و الشيء نفسه إذا كان يريدك أن تقوم بدور رجل أعرج أو رجل السياسة...، فعملك ينحصر في لعب الدور الذي حدد لك، أما الإخراج فلا تسأل، إنه من عمل غيرك."[1] و هكذا فالمتسول في رأي 'إبكتيت' لم يكن كذلك لأنه ارتأى، بناءا على حساباته و تقديراته العقلية، أن التسول هو أفضل السبل و أكثرها ملائمة لقدراته من أجل ضمان حياته و قوته اليومي، وإنما هو كذلك، أي متسولا، لأن المخرج الذي هو الله ارتأى أن تكون مسرحية الحياة الدنيا تتضمن متسولين، وحدد أشخاصا بعينهم لتمثيل هذا الدور فكان لزاما عليهم تأديته على الوجه الأكمل، وبدون أدنى تبرم أو شكوى. و نفس الأمر بالنسبة لباقي الأدوار الأخرى فهي جميعها محددة سلفا من قبل رب العالمين الذي اختار ومنذ الأزل من يقوم بأداء و تشخيص كل واحدة منها. وهو الموقف نفسه الدي نجده عند واحد من كبار الفلاسفة المسلمين وهو الفيلسوف المغربي أبي الوليد ابن رشد الذي اعتقد أن أفعال وتصرفات الأفراد مفروضة عليهم بقوانين الطبيعة وبقوى الجسد وهي كلها مخلوقة من قبل الله تعالى وما على الإنسان سوى الخضوع لمقتضياتها.
أما بالنسبة ل'سبينوزا' فقد اعتبر أن أفعال وتصرفات الأفراد بكل تفاصيلها مفروضة عليهم بقوانين كلية وثابتة هي نفسها قوانين الكون والطبيعة. فعلى غرار قطعة الحجر التي لا تمتلك، بعد تلقيها الدفعة أو الحركة الأولى، الحرية في اختيار التوقف أو الاستمرار في الحركة وإنما تعمل على تنفيذ مقتضيات مبدأ العطالة، لا يمتلك الإنسان أدنى حرية في اختيار الأفعال التي ستصدر عنه بما في ذلك أبسطها كالكلام أو عدمه، و إشباع رغبة أو تأجيلها على سبيل المثال، يقول 'سبينوزا':" فقد أثبتت التجربة بما فيه الكفاية أن أقل ما يمكن للبشر التحكم فيه هو تحكمهم في ألسنتهم، وأنهم لا يقدرون على شيء أقل من التحكم في شهواتهم"[2] فكون الإنسان يمتلك العقل في رأي 'سبينوزا' لا يجعل منه كائنا أسمى من الطبيعة، ومخالفا في تصرفاته لمقتضيات قوانينها، وإنما يجعله فقط، وهذا ما يميزه عن باقي الموجودات الأخرى، يعي انتماءه إلى الطبيعة و يعي ما يصدر عنه من أفعال و تصرفات، ووعيه هذا هو ما يجعله يعتقد بأنه حر، وبأن كل ما يصدر عنه هو نتاج قرارات حرة اتخذها بمحض إرادته وبعيدا عن أي إكراه، غير أن اعتقاده هذا هو اعتقاد خاطئ في رأي هذا الفيلسوف، إنه ليس أكثر من حكم مسبق مبني على جهل مطبق بالأسباب الحقيقية المتحكمة في الأفعال و التصرفات، يقول 'سبينوزا': "إن الناس يظنون أنفسهم أحرارا لمجرد كونهم يعون أفعالهم و يجهلون الأسباب المتحكمة فيهم"[3] فكون الفرد يجهل تماما الأسباب و الدوافع الكامنة وراء تصرفاته، وفي الوقت نفسه وعيه بها، هو ما يجعله يعتقد بأن تلك التصرفات هي نتاج لأرادته الحرة، بينما هي ليست كذلك بالمطلق، والدليل على أنها ليست كذلك هو أن " التجربة تثبت أننا نندم على العديد من الأفعال التي تصدر عنا، وأننا غالبا ما ندرك الأفضل ونتبع الأسوأ."[4]
إن هذا الإنكار لقدرة الإنسان على خلق أفعاله وعلى التصرف بمحض حريته واختياره سيتعمق أكثر مع ظهور ما يسمى بالعلوم الإنسانية، التي و إن كانت قد استبعدت من مجال الفعل الإنساني أي تدخل للقوى الغيبية المفارقة، فهي ستجعل من سلوكات الأفراد مجرد استجابات آلية و ميكانيكية لشروط وحتميات خارجة عن نطاق إرادتهم و حريتهم. فمع التحليل النفسي ، الذي ظهر مع الطبيب النمساوي 'سيغموند فرويد Freud'[5], ليست الميولات و المواقف التي توجد لدى شخص ما في لحظة زمنية ما، و التي تشكل مجتمعة ما يسمى شخصيته، سوى نتيجة حتمية لمجموع العقد و الأزمات النفسية التي تعرض لها في مرحلة سابقة وبصفة خاصة في مرحلة الطفولة. فالفرد الإنساني محكوم في رأي هذا العالم النفساني بثلاث قوى أساسية، ذات مطالب متناقضة، هي: الهو، الأنا، الأنا الأعلى. فالهو الذي يمثل الرغبات والغرائز يطالب الفرد بالإشباع و بتحقيق اللذة، بينما الأنا الذي يمثل الواقع فهو يطالبه بالامتثال لمقتضيات العالم الخارجي، أما الأنا الأعلى الذي يمثل القيم الأخلاقية والدينية فيطالبه باحترام قواعد معينة في سلوكه. وبحكم التناقض الحاصل بين مطالب هذه القوى الثلاث فإن التوفيق فيما بينها يبدو أمرا مستحيلا. غير أن هذا الأمر المستحيل هو بالضبط ما على الفرد القيام به إن أراد أن يضمن لنفسه حياة نفسية سوية،لأن التفريط في مطالب أي قوة من هذه القوى، أو تغليب إحداها على الأخرى، يولد لدى الفرد أزمات وعقد نفسية تظل تؤثر عليه طيلة حياته، وتطبع شخصيته المستقبلية بسمات و خصائص لا يدري هو نفسه مصدرها. وهذا هو واقع حال السواد الأعظم من أبناء الجنس البشري في رأي 'فرويد'،فهم كلهم، إلا فيما ندر، مرضى من الناحية النفسية، لأن لا أحد بإمكانه إشباع كل متطلبات الهو و في الوقت نفسه مراعاة مقتضيات الواقع من جهة، وإلزامات الأنا الأعلى من جهة ثانية. وهكذا فبداخل كل فرد هناك عقد نفسية هي التي تفرض عليه مواقف ونماذج للسلوك عليه أن يتبناها ويتصرف بمقتضاها. فحتى المواقف و السلوكات التي تبدو أنها من نتاج إرادتنا و اختياراتنا الحرة فهي ليست كذلك إلا في ظاهرها،أما في حقيقتها فهي ليست أكثر من نتيجة حتمية لتلك العقد النفسية التي نحملها و التي تولدت لدينا في الماضي بفعل فشلنا الحتمي في مهمة التوفيق بين مطالب كل من الهو، الأنا، الأنا الأعلى.
أما مع علم الاجتماع فليست مواقف و ميولات الشخص في لحظة زمنية ما و التي تشكل مجتمعة شخصيته، سوى نتيجة حتمية للتأثيرات المختلفة التي مارسها عليه المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق التربية و التنشئة الاجتماعية[6]. أي أن شخصيتنا في رأي علماء الاجتماع ليس نحن هم الذين نختارها بمحض إرادتنا وبإمكاننا أن نغيرها متى شأنا، وإنما المجتمع هو الذي يحددها لنا و يفرضها علينا، وهو الذي يمكنه أن يفرض علينا في لحظة ما تغييرها أو إدخال تعديلات عليها، لأنه إذا كانت التربية هي المحدد الرئيسي لما سيكونه الطفل في المستقبل، فهذا الطفل ليس له أدنى دخل في اختيار نوعية وطريقة التربية التي سيتلقاها، بل المجتمع من أسرة و مدرسة و حي...الخ هو الذي يحدد كل ذلك، و تبعا لهذا فليس للفرد أدنى حرية في اختيار ما يكونه بل ما يكونه مفروض عليه قسرا.
إن ما يجمع كل المواقف السابقة هو نفيها للحرية الإنسانية و لقدرة الفرد على تحديد و اختيار شخصيته و مصيره بنفسه، وهو ما عبرت عنه البنيوية بجملة واحدة هي "موت الإنسان"[7].وهو الموت الذي ستنهض ضده الفلسفة الوجودية بزعامة 'جان بول سارتر Sartre' الذي سيدافع وباستماتة، وضدا على كل التصورات السابقة، عن الحرية الإنسانية وعن قدرة الإنسان على صنع مصيره بنفسه. فالإنسان حسب هذا الفيلسوف هو "الكائن الوحيد الذي يسبق وجوده ماهيته"[8] أي أنه الكائن الوحيد الذي لا يتحدد وجوده انطلاقا من قوالب جاهزة ومعدة سلفا وإنما "يوجد أولا وبعد ذلك يختار ما سيكونه"[9] فالشروط والمحددات النفسية والاجتماعية والاقتصادية...الخ. ليست بالنسبة للإنسان سوى معطيات و مواد أولية لبناء مشاريع مستقبلية خاصة ومتفردة هي التي تحدد مصيره. وتبعا لذلك فتصرفات الأفراد و مواقفهم لا تعبر عن استجابات ميكانيكية و آلية لتلك الشروط و المحددات، وإنما تعبر عن حريتهم وقدرتهم الإبداعية، التي تتمثل في إضافة معاني جديدة وشخصية لتلك الشروط و المحددات، بمقتضاها تصبح حياة كل فرد عبارة عن مشروع ذاتي خاص و متميز "فالإنسان - يقول سارتر- ليس شيئا آخر غير ما هو صانع بنفسه، إنه لا يكون إلا بحسب ما ينويه وما يشرع في فعله"[10] لا بمعنى أن الشروط الموضوعية القائمة ليس لها تأثير على ما سيكونه الفرد بحيث يمكن إلغاؤها و نفيها كليا، وإنما بمعنى أن الإنسان قادر على التصرف وبحرية تامة انطلاقا من الإمكانات التي تتيحها تلك الشروط، فهذه الأخيرة لا تفرض مسارا واحدا بعينه، وإنما تنفتح على مسارات و إمكانات متعددة، و الفرد نفسه هو الذي يختار منها ما يراه ملائما. فإذا كانت نفس الأسباب، في مجال الوجود الفيزيائي، تفرض و تؤدي حتما إلى نفس النتيجة، ففي مجال الوجود الإنساني ليس الأمر كذلك، إذ تؤدي نفس الأسباب إلى نتائج متباينة بل ومتناقضة. فمهما تشابهت المؤثرات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية..الخ، التي يمكن أن يتعرض لها مجموعة من أفراد النوع الإنساني، فإن ذلك لن ينتج عنه أبدا وجود تشابه في شخصياتهم المستقبلية، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرض عليهم نفس المصير، وفي هذا دليل قاطع على أن ما يحكم الوجود الإنساني ليس هو قانون العلية وإنما هو قانون الحرية.
نفس هدا الموقف نجده عند الفيلسوف الفرنسي المعاصر "موريس ميرلوبونتي" فقد اعتقد هو الآخر أن الحرية هي صميم الوجود الإنساني، فكون الإنسان يمتلك الوعي يجعله برأيه قادرا على الإفلات من كل قيد أو حد، وذلك بمجرد التفكير في هذا القيد أو هذا الحد. لأن الوعي أو الشعور- كما يقول – هو بطبيعته انفصال ومفارقة وحرية، أي أنه ينطوي في صميمه على قدرة مستمرة على الانفصال عن الواقع،وعلى التحرر من شتى الحدود والقيود.
واضح مما سبق أن الإنسان وإن كان حرا فحريته تلك تظل نسبية ومحدودة، إنها حرية مشروطة بالمعطيات البيولوجية والفيزيولوجية التي يتمتع بها كل فرد، وبالمحيط الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيش فيه .
المحور الثاني: حرية الإرادة
تعتبر الإرادة محددا رئيسيا للعديد من الأفعال والتصرفات التي تصدر عن الإنسان ، بل هي السبب النهائي والوحيد الدي يمكن من خلاله تفسير لماذا أقدم هذا الفرد أو ذاك على هذا العمل دون سواه، ولماذا تبنى هذا الاختيار دون غيره، إلى حد يمكن معه القول أنه إذا كان الإنسان كائن حر فمصدر حريته تلك هي الإرادة الحرة التي يمتلكها، لكن هل الإرادة التي يمتلكها الإنسان فعلا حرة؟ وإدا كانت كدلك فهل حريتها تلك هي حرية مطلقة أم نسبية؟ وهل تسيطر إرادتنا على كل أفعالنا أم على بعضها فقط؟ ماهي مجالات الفعل الإنساني التي يمكن اعتبارها خاضعة لإرادته وما هي تلك التي يمكن اعتبارها تقع خارج نطاق مملكة الإرادة البشرية؟
لقد ميز الفيلسوف المغربي الشهير " أبو بكر ابن باجة" في أفعال الإنسان بين نوعين: أفعال يختارها عن إرادة (الإرادة الكائنة عن روية)، وهي وحدها التي تستحق أن تسمى أفعالا إنسانية في رأيه، لأنها خاضعة للفكر، محددة بما يوجد في النفس من رأي أو اعتقاد، ويسبقها تدبير وترتيب، وأفعال لا يختارها عن إرادة، وإنما تفرض عليه بالانفعالات التي تتقدمها في النفس، وهذه لا تستحق أن تسمى أفعالا إنسانية وإنما أفعالا بهيمية فقط، لأنها مجرد ردود أفعال آلية ، ميكانيكية، خالية من كل تدبير مسبق، وغير مؤسسة على تفكير قبلي؛ وهكذا فكسر إنسان لعود خدشه لمجرد أنه خدشه، يعتبر فعلا بهيميا، لأنه مجرد رد فعل انفعالي على ما أصابه، أما كسره لئلا يخدش غيره، فهو فعل إنساني لأنه محدد بتفكير وروية.
إن تميز ابن باجة هذا بين الأفعال الإرادية وتلك التي ليست كذلك وإن كان لا يبين لنا باضبط مجالات اشتغال الأرادة الأنسانية، فهو يبين بشكل واضح أن الإرادة هي ما يجعل فعلا ما فعلا إنسانيا، فكل فعل يصدر عن الإنسان غير محدد بإرادة فهو لا يستحق ان يسمى فعلا إنسانيا وإنما هو فعل بهيمي فقط، وهو ما يعطي للإرادة قيمة سامية ويرفعها إلى مصاف الملكات الشريفة التي يمتلكها الإنسان والتي يمثل اتباع أوامرها شرط ضروري للارتقاء في سلم مراتب الوجود ليصبح أكثر أكثر قربا من مرتبة الألوهية، و وأكثر بعدا من مرتبة البهيمة.
لقد ظلت الإرادة تحتفظ بنفس القيمة التي حددها لها ابن باجة منذ القرن لدى العديد من الفلاسفة سواء في الفترة الحديثة أو في الفترة المعاصرة، ففي الفترة الحديثة دافع كل من ديكارت وكانط عن أهمية الإرادة في مجال الفعل الإنساني مع اختلاف أساسي بينهما وهو أن الأول أي ديكارت ربطها بمجال المعرفة بينما الثاني أي كانط ربطها بمجال الأخلاق. فحسب ديكارت المعرفة هي المجال الحقيقي الذي تستطيع فيه الإرادة الحرة أن تشتغل و تصدر أحكامها، بل أن ما يعصم الإنسان من الوقوع في الخطأ في رأي ديكارت هو حرية الإرادة التي يمتلكها وقدرته على حسن استعمالها ، وهكذا، كما يقول ديكارت في كتابه "تأملات ميتافيزيقية": "الأحكام التي نصدرها عن الأشياء ،تكون معقولة كلما كانت الإرادة حرة ". أما حسب كانط فالمجال الوحيد الذي يمكن التكلم فيه عن إرادة حرة هو مجال الأخلاق ،حيث يقول في كتابه " أسس ميتافيزيقيا الأخلاق: "إن الإنسان بوصفه كائنا عاقلا يستطيع اعتمادا على إرادته الحرة ، وضع القواعد العقلية للعقل الإنساني و الخضوع لهذه القواعد" وهو ما يعني أن الإرادة الحرة للإنسان ستصبح مع إيمانويل كانط، المبدأ الأسمى للأخلاق، لأنها، من جهة، تمثل مصدر الأمر الأخلاقي المطلق الذي يصلح لكل إنسان وفي كل زمان ومكان، ومن جهة ثانية، ستزيل كل تعار ض ممكن بين الحرية و الواجب على اعتبار أن خضوعنا لإرادتنا الحرة واحترامنا للواجبات والقوانين الأخلاقية هما في نهاية التحليل شيء واحد، لأن مصدرهما واحد هو ذاك الذي اتخذ منذ كانط إسم "سلطان اإرادة".
أما في الفلسفة المعاصرة فقد رفض كل من الفيلسوف الفرنسي " جان بول سارتر" والفيلسوف الأمريكي "أليكسيس توكفيل" أي تقييد للإرادة ، وأي تحديد لمجالات اشتغالها فحسب "توكفيل" بقدر ما عند الإنسان من إرادة بقدر ما عنده من حرية " حيث يوضح في كتابه – الديمقراطية في أمريكا – أن الإرادة الحرة لدى الفرد وحدها التي تبعده عن العبودية و تضمن له التمتع بحريته السياسية والآجتماعية والآقتصادية. . . الخ، فكل هذه الأشكال من الحرية التي يمكن للفرد أن يتمتع بها أصلها واحد ومصدرها واحد وهو حرية الإرادة التي يمتلكها والتي تتسع حريته بقدر اتساعها على حد تعبيره. أما حسب "سارتر" فالحرية هي نسيج الوجود الإنساني بأكمله، حيث يقول معبرا بوضوح عن هذا المعنى: "إن الإنسان حر، الإنسان حرية... الإنسان محكوم عليه أن يكون حرا، محكوم عليه لأنه لم يخلق نفسه وهو مع ذلك حر لأنه متى ألقي به في العالم، فإنه يكون مسؤولا عن كل ما يفعله"، وهكذا بدون الحرية لن يكون الإنسان إنسانا أصلا ، بدون الحرية سيموت الإنسان، لأن هذه الأخيرة ليست مجرد شيء عرضي أو زائد في الوجود الأنساني بل هي الما هية الوحيدة المحددة لهذا الوجود، أو لنقل مع سارتر إنها الوجود الإنساني نفسه حيث بانتفائها سينتفي هو نفسه وسيصبح مجرد وجود طبيعي أو فيزيائي وليس أبدا وجودا إنسانيا.
رغم هذا التقديس الذي تمتعت به الإرادة، ورغم تلك القيمة السامية التي منحها لها الفلاسفة على امتداد تاريخ الفلسفة، فإن هذا الأخير لا يخلو من بعض الآراء والتصورات الفلسفية التي ستبعد مجال اشتغال الإرادة الحرة، ليس من المعرفة فقط، وإنما من الأخلاق أيضا، ليتم ربطها بما هو حيواني في الإنسان أي بالغرائز والنموذج البارز الذي دافع عن هذا التصور هو الفيلسوف الألماني "فريدريك نيتشه" الذي جاءت أفكاره معادية تماما لأفكار كل من ديكارت (الذي ركز على المعرفة وربط الإرادة بها) و كانط (الذي ركز على الأخلاق التي ربطها بسلطان الإرادة)، فحسب نيتشه ليس هناك أي مبرر أدى إلى الإعلاء من قيمة العقل ومن قيمة الأخلاق سوى أنهما أثبتا نجاعتهما في معركة الصراع من أجل البقاء وتبعا لذلك فهما معا ليس سوى تابعين لإرادة أقوى هي ما يسميه "إرادة الحياة"، ومن ثمة فإن اتباعهما لا يؤدي إلا إلى التعلق بأوهام تقدم ذاتها في صورة قيم و مثل عليا مفارقة، تتخذها كأقنعة و كمبررات يعلن باسمها الجهاد ضد الحياة، و الحرب ضد الوجود، الشيء الذي يؤدي إلى انتصار ما يسميه نيتشه ب"القوى الارتكاسية" في الإنسان، بدل انتصار "القوى الفاعلة" فيه، فالإرادة التي دافع عنها كانط وأعلى من شأنها هي في رأي نيتشه "إرادة إنكارية" لأنها تقوم على تبخيس الحياة، وذلك في مقابل إرادة أخرى يدافع عنها هو، و يسميها " إرادة توكيدية" وهي إرادة تقوم على تمجيد الحياة والإعلاء من شأنها، الأولى تعبر عن حياة مرضية أصابها الوهن و الضعف و الإعياء، ولم تعد قادرة على مواجهة تناقضات الحياة ومفارقاتها، فضلا عن آلامها وشرورها،بينما تعبر الثانية
عن حياة قوية و سليمة، تتمتع بصحة جيدة، قادرة على الانفتاح على الحياة وعلى توكيدها بكل تناقضاتها ومفارقاتها وبكل شرورها وأحزانها، وهكذا فإن الإرادة الحرة التي دافع عنها كانط هي إرادة الضعيف، بينما التي ينادي بها نيتشه، ويدافع عنها، هي إرادة القوي أو ما سماه نيتشه بالضبط "إرادة القوة" .
بغض النظر عن الاختلافات السابقة بين مواقف الفلاسفة من الإرادة ومجالات اشتغالها فالأمر اليقيني والمؤكد والذي لا يمكن الاختلاف فيه هو أن الإرادة هي المصدر الرئيسي إن لم يكن الوحيد لحرية الإنسان ولقدرته على التحرر من شتى القيود التي تفرض عليه من كافة النواحي.
المحور الثالث:الحرية والقانون
تقترن الحرية بكل تأكيد بالإرادة الحرة للفرد وبقدرته على فعل كل ما يريد بعيدا عن أي ضغط أو إكراه، لكن إذا فعل كل شخص كل ما يريده ألا يمكن لذلك أن يؤدي إلى فوضى؟ ألا يمكن أن تتعارض إرادة فرد مع إرادة فرد آخر أو أفراد آخرين، فتؤدي حريتهما تلك إلى تقاتلهما، و تبعا لذلك شقائهما، بدل أمنهما وسعادتهما؟ أليس من الضروري، كي يتمتع الأفراد حقيقة بحريتهم، وجود قوانين تنظم تلك الحرية نفسها؟ لكن من جهة ثانية ألا يؤدي تقنين أفعال وتصرفات الأفراد بقوانين وإرغامهم على عدم تجاوزها نفي لحريتهم، أم أن الأمر عكس ذلك بحيث وجود مثل تلك القوانين شرط ضروري لوجود الحرية ولتمتع الأفراد بها؟
إن انتماء الإنسان إلى عالم الطبيعة و تموقعه كجزء لا يتجزأ منها جعل العديد من الفلاسفة يعتقدون بأن قوانين الطبيعة يجب أن تكون هي المعيار والنموذج الموجه لكل سلوكاتنا وأفعالنا، وأن حرية الأفراد، شأنها في ذلك شأن حرية باقي الكائنات الأخرى يجب أن تتحدد من خلال نظام الطبيعة وقوانينها، لأنها وحدها ثابتة و مطلقة، وهكذا سيؤكد جل الفلاسفة والمفكرين السياسيين خلال القرنين 17و18مثل توماس هوبز، جون جاك روسو، جون لوك، باروخ سبينوزا...الخ على أن حرية كل كائن تتحدد من خلال الخصائص التي زودته الطبيعة بها، و التي تحدد نمط وجوده وحياته: فإذا كانت الطبيعة زودت السمك بخاصية السباحة وأكل كبيره لصغيره، فإن ذلك يجعل من سباحة السمك في الماء، وأكل كبيره صغيره، من صميم حريته، و الأمر نفسه ينطبق على الإنسان أيضا، فما دامت الطبيعة زودت كل فرد برغبات وقدرات وغرائز خاصة، فإن حريته في رأي هؤلاء الفلاسفة تتحدد من خلال ذلك، أي أن كل ما يقدر عليه الفرد ويرغب فيه فهو حر في أن يتجه إليه ويعمل على تحقيقه ،وبذلك يكون الإنسان وفق قوانين الطبيعية يمتلك حرية مطلقة في القيام بكل ما يشتهيه ويقدر عليه.
غير أن عيش الإنسان وفق هذه الحرية الطبيعية، وإن كان يجعل حريته تلك حرية مطلقة فذلك لا يستطيع أن يضمن له حياة سعيدة وآمنة ، بل إن العيش وفق هذه الحرية يؤدي إلى "شقاء عظيم" كما يقول سبينوزا،وإلى حرب الكل "ضد الكل " كما يقول توماس هوبز،حيث غياب الأمن والاستقرار، وسيادة العنف والفوضى. ونظرا لكون الإنسان ميال بطبعه للأمن والاستقرار، فقد كان لزاما عليه الانتقال من العيش وفق الحرية الطبيعية التي تتحدد من خلال الرغبة والقدرة، إلى العيش وفق الحرية المدنية و الثقافية التي تحدد من خلال قوانين يتم التعاقد والاتفاق حولها. وهكذا ستصبح الحرية كما يعرفها مونتيسيكيو هي : " أن يقدر المرء على أن يعمل ما ينبغي عليه أن يريد، وألا يكره على عمل ما لا ينبغي أن يريد"، أي الحق في أن يعمل المرء ما تجيزه القوانين العادلة فقط، وليس كل ما يرغب فيه ويقدر عليه، لأن بدون ذلك، ستنتفي الحرية وتتلاشى. وهكذا ستصبح الحرية مع مونتسكيو مرتبطة بالقانون ومحددة به بالقانون، وهو الربط نفسه الذي سيسير به روسو بعيدا إلى الأمام. فما دام المصدر الوحيد للقوانين هو إرادة أفراد الشعب أنفسهم فإن خضوعهم لتلك القوانين لا ينطوي على أ إلزام أو إكراه وتبعا لذلك فهو لا يتعارض مع تمتعهم بحريتهم، وهكذا فإن انتقال الإنسان من العيش وفق حريته الطبيعية المحددة بقدراته ورغباته، إلى العيش وفق حرية مدنية محددة بقوانين وضوابط متعاقد حولها،لا يعني تقييدا لحريته أو إلغاء لحقوقه الطبيعية، وإنما يعني فقط تنظيم لهذه الحرية ولتلك الحقوق بحيث يصبح بالإمكان الاستفادة منها وممارستها بعيدا عن كل خوف أو تهديد.
واضح إذن أن الأصل في كل حرية هي الطبيعة نفسها، غير ضمان الاستمتاع بشكل كامل بها ، و مهما كان، يقتضى بالضرورة إخضاعها لقواعد تنظمها وتقنن ممارستها.
نفس الصفحة[/size] | |
|