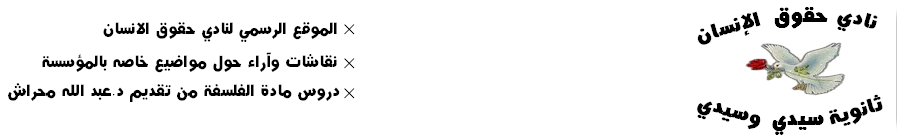abdo2.mohrach
إدارة الموقع


عدد المساهمات : 40
تاريخ التسجيل : 01/01/2009
 |  موضوع: درس الدولة من اعداد الفريق التربوي بفاس موضوع: درس الدولة من اعداد الفريق التربوي بفاس  الأربعاء أبريل 14, 2010 4:57 am الأربعاء أبريل 14, 2010 4:57 am | |
| الدولة مقدمة : بالرجوع إلى جملة من المعاجم، كمعجم لالاند، معجم روبير، معجم لاروس...الخ يمكن تقديم التعريف التالي للدولة: الدولة هي كل تجمع بشري تتوفر فيه الشروط التالية: 1- أنه كبير نسبيا من حيث عدد أفراده. 2- أنه مستقر في مجال جغرافي معين. 3- أنه يتوفر على حكومة تعمل على تدبير شؤون أفراده العامة والمشتركة. 4- أن هذه الحكومة تعمل وفق قوانين، وبالاعتماد على جملة من الأجهزة و المؤسسات هي جميعها منبثقة من دستور. إن هذا التعريف بقدر ما هو واضح وجلي بقدر ما هو غامض وإشكالي، ولعل ما يجعله كذلك أمور ثلاثة على الأقل بعاد كل بعد من ابعاد كل عنصر من عناصر هذا : أولها أن وظيفة الدولة هي بكل تأكيد تدبير الشأن العام والمشترك للأفراد، أو ما يعرف بالحياة العامة، لكن على ماذا يدل بالضبط قولنا "الشأن العام"،"الحياة العامة"، أين ينتهي الشأن الخاص وأين يبدأ الشأن العام؟ ما هي الحدود الفاصلة بين ما هو عمومي وما هو خصوصي؟ وتبعا لهذا ما هي الحدود التي يجب أن يقف عندها تدخل الدولة في شؤون الأفراد؟ ما هي الغايات بالضبط التي من أجل تحقيقها توجد الدولة؟ وهل هذه الغايات تتأسس عل ما هو بيولوجي طبيعي في الإنسان، فتكون الدولة قد لازمته منذ وجوده ، أم أن هذه الغايات تتأسس على ما هو ثقافي مكتسب، فتكون الدولة مكسبا حضاريا لم يهتد الإنسان إليه إلا بعد رحلة طويلة من تاريخه؟ بعبارة موجزة : ما أصل الدولة ؟ وما الغاية من وجودها ؟ ثانيهاأن كل دولة لكي تدبر شؤون الأفراد، وتحقق الغايات التي من أجلها وجدت، تحتاج إلى جملة من الأجهزة وعدد من السلط. فما طبيعة هذه الأجهزة والسلط : هل هي ذات طبيعة مادية مرئية أم أنها ذات طبيعة معنوية خفية؟ هل تنحصر سلطة الدولة في الهيئات مثل الهيئةالتشريعية والقضائية والتنفيذية، وفي المؤسسات مثل المحكمة والسجن، أم أنها تتعدى كل ذلك لتحضر حتى في الأسرة والصحافة والجمعيات وفي كل القوى الفاعلة الأخرى داخل الجماعة، بما في ذلك تلك التي يبدو أنها تعمل ضد السلطة؟ ثالثها سواء كانت السلطة مقتصرة على مؤسسات وأجهزة بعينها، أو كانت "حالة بكل مكان وتأتي من كل صوب" كما يقول فوكو، فكيف تمارس فعلها داخل المجتمع: هل من خلال القوة أم من خلال القانون؟ من خلال العنف و الإكراه أم من خلال الحق والعدالة؟ المحور الأول: مشروعية الدولة وغاياتها لقد شكلت الدولة مع اليونان موضوعا خصبا للتأمل الفلسفي، فقد عالجها أفلاطون في كتب عدة، منها الجمهورية، والقوانين، وخصص لها أرسطو مادة دسمة في كتابه "في السياسة"، فكيف نظر هذان الفيلسوفان إذن إلى الدولة؟ ما غاياتها وما أساس وجودها ؟لقد آمن كل من أفلاطون وأرسطو بفكرة وجود لا مساواة طبيعية بين الناس، أي أن هؤلاء يوجد بينهم بالفطرة والطبيعة تفاوت وتمايز سواء من حيث القدرات الجسمية أو من حيث القدرات العقلية، وهذه الفكرة هي ما يشكل الأساس الفلسفي لتصور كل من أفلاطون وأرسطو للدولة. ففي نظر أفلاطون، كما تنقسم النفس إلى قوى ثلاث: شهوية ، غضبية وعاقلة، ينقسم أفراد النوع الإنساني إلى فئات ثلاث: حرفيون، جنود وحكام. وكما أن الوظيفة الطبيعية للنفس العاقلة هي توجيه عمل النفس الشهوية والنفس الغضبية بالشكل الذي يضمن الانسجام والتناغم في حياة الفرد، فإن وظيفة الحكام هي تدبير شؤون الحرفيين والجنود، وتوجيه عملهم نحو تحقيق الانسجام والتناغم في حياة الجماعة التي ينتمون إليها. فالعدالة، كما يقول أفلاطون في كتاب الجمهورية، هي "أن يؤدي كل فرد وظيفة واحدة في المجتمع هي تلك التي وهبته الطبيعة خير قدرة على أدائها" غاية الدولة إذن بالنسبة لأفلاطون هي تحقيق الانسجام والتناغم بين مكونات المجتمع، وهو تناغم لا يتحقق إلا "بانصراف كل فئة إلى أداء المهمة التي هيأتهم الطبيعة للقيام بها دون التدخل في مهام الفئات الأخرى"، فمن هيأته الطبيعة أن يكون حرفيا، وزودته بما يلزم ذلك من مهارات وقدرات، فلا مفر له من أن يكون كذلك وينجز ما يلزمه من المهن والصنائع، ومن هيأته أن يكون محاربا فعليه أن يحمل السلاح ويقف بشجاعة ضد كل خطر يمكن أن يهدد الجماعة، ومن هيأته أن يكون حاكما فعليه أن يتجه لتدبير شؤون الناس بفضيلة وحكمة وعدل. وهكذا فالدولة من الأمور الطبيعية عند أفلاطون سواء من حيث غاياتها أومن حيث أصلها ومنشؤها، وهي بذلك قد لازمت الوجود البشري منذ الخليقة. لقد تعرضت الكثير من الأفكار السياسية لأفلاطون لانتقادات لاذعة من قبل أرسطو، لكن مع ذلك يظل هذا الأخير وفيا لمنطلقات أستاذه ولكثير من النتائج التي تؤدي إليها. فأرسطو آمن هو الآخر بوجود تراتب طبيعي بين أفراد النوع الإنساني، بل آمن أكثر من ذلك بان هذا التراتب مقصود من قبل الطبيعة نفسها والتي "لا تفعل باطلا أبدا". فكون الناس مختلفين ومتمايزين على مستوى المهارات والقدرات يجعلهم بالطبيعة في حاجة إلى بعضهم البعض، وبالضرورة ميالين إلى الألفة والاجتماع، لأن لا احد منهم يستطيع أن يوفر بنفسه كل ما يحتاج إليه، "ولا يمكن أن يقدر على ذلك إلا وحش أو إله" وليس أبدا فردا من البشر. بهذا المعنى كان الإنسان" كائنا مدنيا بطبعه" في نظر أرسطو، أي كائنا لا يستقيم وجوده إلا في مجتمع يتقاسم أفراده المهام والوظائف، وبهذا المعنى أيضا كانت الدولة "من الأمور الطبيعية"، أي من الأمور التي يقتضيها تحقيق الحاجات الطبيعية للإنسان والتي بدونها لا يمكن أبدا أن تتحقق. إن غاية الدولة عند أرسطو هي تحقيق الخير الأسمى، "فكل ائتلاف بشري - يقول أرسطو- هو من أجل تحقيق خير ما، وبما أن الدولة هي أسمى ائتلاف، فهي ترمي إذن إلى تحقيق أسمى الخيرات "، وهذا الخير ليس شيئا آخر سوى ضمان سعادة كل الأفراد عبر تحقيق كل احتياجاتهم الطبيعية من غذاء وسكن وأمن . .الخ، وما يجعلها كذلك، أي خيرا أسمى، هو أنها غاية في ذاتها وليست مجرد وسيلة أو غاية من أجل تحقيق غاية أو غايات أخرى.بالنسبة لأرسطو إذن "لقد وجد الإنسان لكي يعيش في دولة" و " لقد وجدت الدولة من أجل تحقيق خيرهم الأسمى الذي هو سعادتهم"، وبذلك كانت الدولة عنده من الأمور الطبيعية سواء من حيث أصلها ومنشؤها أومن حيث أهدافها وغاياتها. على خلاف المؤلفات الأخرى، لم تحظ المؤلفات السياسية لأفلاطون وأرسطو بأهمية كبرى لدى الفلاسفة المسلمين، وسواء كان سبب ذلك هو أنها، أو على الأقل بعضها، لم تصلهم قط، ولم يعلموا أصلا بوجودها، أو كان سبب ذلك هو حيلولة النص الديني دون الاستفادة منها، بفعل ما تضمنه من أحكام سياسية جاهزة، فإن النتيجة واحدة، وهي خلو الفكر الإسلامي من مؤلفات مخصصة لمعالجة القضايا المتعلقة بالدولة كأصلها وغاياتها وأشكال الممارسة السياسية فيها، اللهم بعض المقالات المتناثرة التي توجد هنا أو هناك، في هذا المؤلف أو ذاك، والتي لم تكن أبدا غاية في ذاتها وإنما أملتها فقط سياقات البحث في موضوعات أخرى. لم يستعد إذن مفهوم الدولة أهميته باعتباره موضوعا للتفكير الفلسفي إلا مع العصر الحديث، فالتحولات الهائلة التي عرفتها المجتمعات الأوربية سواء من الناحية العلمية (الانتقال من مركزية الأرض إلى مركزية الشمس) أو من الناحية الاقتصادية (الانتقال من الإقطاعية إلى البرجوازية) أو الاجتماعية (الانتقال من مفهوم القرابة إلى مفهوم المصلحة ) جعلت أنظمة الحكم القائمة غير متوافقة مع روح العصر. فأنظمة الحكم القائمة في جميع أنحاء أوروبا حتى حدود النصف الثاني من القرن 18 مبنية كلها على الوصاية والتبعية، أي وصاية الدولة المطلقة على الأفراد وعلى شؤونهم وتبعيتهم المطلقة لها، بينما جوهر الأنوار أو الحداثة كما يقول كانط ليس شيئا آخر غير" خروج الإنسان من حالة الوصاية تلك "، ومن هنا كان من اللازم على مفكري وفلاسفة هذا العصر البحث عن أسس جديدة للانتظام السياسي وعن تبرير جديد لمشروعية الدولة وما يقتضيه ذلك من تحديد دقيق لغاياتها ووظائفها. فما هي الحصيلة التي انتهى إليها ذلك البحث إذن؟ كيف نظر فلاسفة العصر الحديث إلى الدولة وإلى غاياتها وأسس مشروعيتها؟ يمكن التمييز لدى الفلاسفة اللاحقين على القرن 17 بين ثلاث تصورات أساسية للدولة، الأول نجده عند ما يعرف بأصحاب "نظرية العقد الاجتماعي"، والثاني نجده عند "هيجل"، أما الثالث فنجده عند "ماركس". فبالنسبة لمن يعرف بأصحاب نظرية "العقد الاجتماعي" وأبرزهم جون جاك روسو، توماس هوبز، جون لوك، وباروخ سبينوزا، لم يهتد الإنسان إلى الانتظام في دول ووفق قوانين تسهر على تطبيقها واحترامها سلط وأجهزة، إلا بعد رحلة تاريخية طويلة جرب فيها العيش وفق الحقوق الطبيعية، أي وفق ما تقتضيه إرادته وقدرته وليس وفق ما يقتضيه عقله وضميره الأخلاقي، لأنه ببساطة لم يكن قد وجد بعد لا العقل ولا الضمير الأخلاقي، أو على الأقل لم يكونا بعد قد وصلا إلى مرحلة الاكتمال، وهكذا عاش كل واحد منهم وفق مبدأ طبيعي هو "افعل كل ما تشاء وتقدر عليه" وهو ما يعرف لدى هؤلاء الفلاسفة بالحق الطبيعي وبالحرية الطبيعية، أما هذه المرحلة فتعرف لديهم بحالة الطبيعة. يختلف هوبز وسبينوزا عن روسو ولوك بخصوص تصور كيف كانت حياة الناس في هذه المرحلة؟ كيف كانت أحوالهم وظروف عيشهم؟ فبالنسبة لهما (هوبز وسبينوزا) فإن حالة الطبيعة هي حالة عنف وجور، فكون كل واحد يفعل كل ما يريد ويقدر عليه يجعل لا وجود للحق إلا بالنسبة للأقوى. ولما كان الأقوى نفسه ليس له أي ضمانة على أنه بالفعل الأقوى، خصوصا - كما يقول سبينوزا- " أن الحق والتنظيم الطبيعيين لا يمنعان لا المكر ولا المخادعة ولا الحيلة ولا أية وسيلة أخرى"، فإن النتيجة هي سيادة الخوف والحرب، خوف الكل من الكل، وحرب الكل ضد الكل كما يردد هوبز،وهو المعنى نفسه الذي سيعبر عنه سبينوزا بقوله "الشقاء العظيم". أما بالنسبة لروسو ولوك، فحياة الناس في حالة الطبيعة كانت على عكس ذلك تماما، لقد كانت حياة سعيدة مليئة بالعدل والمساواة، لسبب بسيط ، هو أنه لم يكن بعد قد وجد ما يخلق التفاوت فيما بين الناس، ولا ما يمكنهم أن يتصارعوا من أجله. فالناس في هذه المرحلة كانوا يعتمدون في قوتهم على ثمار الأشجار ولحوم الحيوانات، وفي مسكنهم على الكهوف والمغارات، وهي جميعها كانت وفيرة وليست ملكا لأحد، لذا لم يكن هناك أي مبرر أن يتصارعوا ويتحاربوا فيما بينهم، أو في أن يخاف بعضهم من البعض، بل على العكس، كان جمع الثمار واصطياد الحيوانات يقتضي منهم تعاونا و تآزرا لم يحرموا منه إلا بعد ظهور الملكية الفردية، أي بعد أن " سيج أحد الأفراد قطعة من الأرض وقال للآخرين: لا تدخلوها إنها ملك لي "، فعند ذلك فقط بدأ التفاوت، وبدأ التخوف من حدوث العنف والظلم، الأمر الذي دفعهم من أجل تجنب حصوله أن يبرموا فيما بينهم عقدا ينتقلون بمقتضاه إلى العيش داخل دولة تسهر على أمن وحرية كل واحد منهم. وسواء كانت حالة الطبيعة عنف وجور(هوبزو سبينوزا)، أو كانت سعادة ومساواة (روسوولوك)، فإن النتيجة التي ينتهي إليها كل الفلاسفة السابقين واحدة، وهي أن أصل الدولة هو العقد الاجتماعي، أي اتفاق وتعاقد أبرمه الأفراد فيما بينهم في مرحلة معينة من تاريخهم، إما من اجل إنهاء حالة العنف والفوضى التي كانوا يعيشونها كما اعتقد هوبز وسبينوزا، وإما من أجل تجنب حدوث ذلك في المستقبل كما اعتقد لوك وروسو. ومن هنا فإن غاية الدولة بالنسبة لهم جميعا هي ضمان استمتاع الأفراد بحقوقهم الطبيعية دون خوف أو عنف، أي دوام استمتاعهم بحريتهم وأمنهم. " فالغاية القصوى من تأسيس الدولة – يقول سبينوزا- ليست السيادة أو إرهاب الناس، بل هي تحرير الفرد من الخوف، بحيث يعيش كل فرد في أمن وآمان بقدر الإمكان . . فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة" وهو نفس المعنى الذي يتكرر عند لوك بكلمات مغايرة حين يقول "يبدو لي أن الدولة جماعة من الناس تكونت لغرض وحيد هو المحافظة على خيراتهم المدنية وتنميتها. وأنا أقصد ب'الخيرات المدنية' الحياة، الحرية، سلامة البدن وحمايته ضد الألم، وامتلاك الخيرات الخارجية مثل: الأرض، النقود، المنقولات. .الخ". الدولة بالنسبة لأصحاب العقد الاجتماعي إذن هي مكسب حضاري حققه الإنسان في لحظة ما من تاريخه، أساسها اتفاق وتعاقد فيما بينهم، وغايتها ضمان أمنهم وحريتهم. يتفق هيجل مع أصحاب نظرية "العقد الاجتماعي" بأن الدولة مكسب حضاري لم يهتد الإنسان إلى العيش في كنفه إلا بعد أشواط طويلة من تاريخه، لكنه يرفض رفضا باتا أن يكون الأصل في وجودها وتحققها اتفاق وتعاقد تم بين الأفراد، أو أن تكون غاياتها النهائية هي ضمان أمنهم وحريتهم. إن وجود الدولة في رأي هيجل وتحققها في الواقع الإنساني هو ضرورة أملتها "الصيرورة التاريخية"، التي ليست شيئا آخر غير التحقق التدريجي "للروح المطلق"، ذلك التحقق الذي لا يحكمه سوى منطق واحد هو منطق النفي ونفي النفي أو ما يعرف لدى هيجل بالمنطق الجدلي، الذي يقتضي لكل شيء نقيضه ولكل نقيضين وحدة كلية أسمى منهما يذوبان فيها وينتفي التناقض بينهما. ففي البداية كانت هناك في رأي هيجل "الأسرة" التي هي أول تحقق للروح الموضوعي والذي هو نفسه ليس سوى مرحلة متقدمة من الروح لمطلق. غير أن الأسرة لا تحافظ على هويتها ووحدتها بل سرعان ما تتفكك وتتفرع، بفعل زواج الأبناء، إلى أسر كثيرة، فتنتقل من الوحدة إلى الكثرة ومن الهوية إلى التعدد، وهذه الكثرة وهذا التعدد هو ما يسميه هيجل "بالمجتمع المدني" الذي ليس شيئا آخر غير مجموع الأسر الكثيرة والمتعددة والتي تشكل في وجودها نقيضا للأسرة كوحدة وهوية. غير أن هذا التناقض نفسه لا يمكنه أن يدوم ويستمر ولا بد له أن يُحتوى من قبل وحدة كلية أعم وأسمى تجمع بين مصالح الطرفين، أي مصالح الأسرة كوحدة وهوية والمجتمع المدني ككثرة وتعدد، وهذه الوحدة الأسمى ليست شيئا آخر سوى الدولة. ليست مصالح الأفراد إذن، من أمن وحرية، هي التي جعلتهم في رأي هيجل يقررون وبمحض إرادتهم تأسيس الدولة والعيش في كنفها، وإنما كان ذلك نتاج ضرورة اقتضاها الروح المطلق الذي ليست الطبيعة والعقل والأسرة والدين والفن والفلسفة وسائر الأمور الأخرى سوى تجسيدات مختلفة له، ومراحل متباينة من مراحل تحققه. وبناء على هذا التصور يستخلص هيجل أن الدولة غاية في ذاتها وليست مجرد وسيلة لتحقيق غايات خارجية أخرى، سواء كانت السلم أو الحرية أو الملكية، لأنه كما يقول هيجل "إذا جعلنا الغاية الخاصة للدولة هي الأمن، وحماية الملكية الخاصة، والحرية الشخصية، لكانت مصلحة الأفراد بما هم كذلك الغاية النهائية التي اجتمعوا من أجلها. وينتج عن ذلك أن يكون الانتماء للدولة مسألة اختيارية، غير أن علاقة الدولة بالفرد شيء مختلف عن ذلك أتم الاختلاف"، وهكذا فالفرد عضو في الدولة ليس لأنه اختار ذلك في رأي هيجل وإنما لأن الواجب الأسمى يفرض عليه ذلك،" فما دامت الدولة هي الروح وقد تموضعت، فإن الفرد لن تكون له موضوعية، ولا فردية أصيلة، ولا حياة أخلاقية إلا بوصفه عضوا في دولة"، وبالنتيجة فإن مصير الفرد المحتوم هو أن يحيا في دولة، وأن يجعل بشكل كلي من هذه الحياة "نقطة البداية والنهاية" بالنسبة له. ليست غاية الدولة هي الفرد، "أمنه وحريته" كما اعتقد ذلك أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، وإنما الأمر عكس ذلك بالنسبة لهيجل، أي غاية الفرد هي الدولة، قوتها وشموخها، إن الدولة في رأيه غاية في ذاتها، إنها الغاية التي ليس بعدها غاية. لقد استفاد ماركس كثيرا من تحليلات هيجل، خصوصا من منهجه الجدلي الذي ينبني على اعتبار النفي والتناقض هما محركا كل شيء. غير أن التناقض مع ماركس سيأخذ طابعا ماديا مشخصا وليس طابعا عقليا مثاليا كما كان الأمر مع هيجل، فالتناقض الذي أدى إلى ظهور الدولة في رأي هيجل هو تناقض بين 'فكرة الأسرة' و'فكرة المجتمع المدني' أي بين الأسرة كفكرة تحيل على كلية موحدة وبين المجتمع لمدني كفكرة أيضا لكنها تحيل على كثرة مبعثرة ومتعددة، بينما التناقض الذي أدى إلى ظهور الدولة في رأي ماركس هو تناقض مادي، قائم بين أفراد يمتلكون "وسائل الإنتاج" من أراض وآلات، وأفراد آخرون لا يمتلكون سوى "قوة عملهم" يبيعونها للطرف الآخر لكي يحصلون على قوتهم اليومي. هكذا لا يختلف ماركس مع روسو في قوله أن الملكية هي الأصل في ظهور الدولة، وبأن قبل ظهورها كانت هناك مشاعية بدائية تميزت حياة الناس فيها بأسمى درجات العدل والسعادة والمساواة، لكنه يختلف معه في الغاية التي من أجلها كان ذلك الظهور. فهذه الغاية تتمثل عند روسو في ضمان الأمن والحرية لكل الأفراد، بينما تتمثل عند ماركس في ضمان هيمنة الطبقة المسيطرة، المالكة لوسائل الإنتاج على الطبقة الأخرى، أي تلك التي لا تمتلك ذلك. إن الدولة في رأي ماركس هي أداة "للهيمنة الطبقية" ولتكريس "استعباد الأفراد لبعضهم البعض عبر جعله استعبادا مشرعا، له قوانينه التي تسنه، وأجهزته التي تحميه، وإيديولوجيته التي تبرره. ومادام أساس هذا الاستعباد ماديا اقتصاديا، فإنه لا يمكن زواله إلا بإحداث انقلاب وتغيير جذري في ذلك الواقع، وهو ما لا يمكن أن يتم إلا بثورة عارمة تقوم بها البروليتاريا فتتحول بمقتضاها ملكية وسائل الإنتاج إلى ملكية مشاعة ومشتركة بين جميع أفراد المجتمع وليست ملكية خاصة لبعض فئات أفراده فقط، وهو ما يسمى في الماركسية "بالثورة الاشتراكية" أو "الثورة الشيوعية".وسواء كانت الدولة غاية أو وسيلة، أداة لضمان الأمن والاستقرار أو أداة لتكريس الهيمنة والاستعباد، جزء من الطبيعة البشرية أو مكسب حضاري، فإنها في جميع تلك الحالات تحتاج إلى سلط تؤدي من خلالها وظيفتها وتحقق عبرها غاياتها، فأين تتجلى تلك السلط؟ كيف يمكن تحديد طبيعتها وكيفية اشتغالها؟ المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية تعتبر السلطة أمرا ملازما لكل دولة، فهذه الأخيرة لا يمكنها تحقيق غاياتها وإخضاع الأفراد لقوانينها إلا من خلال سلطة تخول ممارستها لجهات وقوى معينة. فأين تكمن وتتحدد الجهات والقوى المخول لها ممارسة السلطة في الدولة؟ هل تتحدد فقط في أجهزة مثل مؤسسات ، أم أنها تتعدى ذلك لتحضر في كل القوى الفاعلة الأخرى في المجتمع بما في ذلك تلك التي يبدو أنها تعمل ضد السلطة؟ هل السلطة متعالية عن المجال الذي تمارس فيه أم أنها محايثة له ومتداخلة معه؟ يميز مونتيسيكيو في كتابه 'روح القوانيين' في السلطة السياسية بين ثلاث أساسية: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الأولى تخول لمن تفوض إليه وضع القوانين لفترة محدودة أو إلى الأبد، وتصحيح أو إلغاء القوانين الموضوعة سابقا. أما الثانية فتخول لصاحبها "إقرار السلم أو الحرب، إرسال واستقبال السفراء، والعمل على استتباب الأمن وحماية البلد من الاعتداءات''، أما الثالثة والأخيرة فيمتلك صاحبها بمقتضاها "سلطة إصدار الأحكام في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد وفي الجرائم التي يرتكبونها". والشرط الضروري الذي يجب أن يتوفر في هذه السلط كي تؤدي وظيفتها وتحقق الغايات التي من أجلها وجدت، والتي تتمثل في "جعل أي مواطن لا يخاف من مواطن آخر" فينعم جميعهم بالحرية والأمن، فهذا الشرط هو أن تكون هذه السلط منفصلة وليست كلها في يد جهة أو هيئة واحدة. فاجتماع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد جهة واحدة " يجعل من الممكن أن تقوم هذه الجهة بسن قوانين استبدادية " ما دامت هي نفسها من سينفذها، ومن طبيعة الحال لا حرية ولا أمن مع الاستبداد. أما اجتماع السلطة القضائية والسلطة التشريعية بيد جهة واحدة فهو سيجعل الأحكام الممارسة على حياة وحرية المواطنين أحكاما اعتباطية، ما دام القاضي سيكون هو المشرع نفسه، وهو ما لا يقل تعارضا عن سابقه مع حرية وأمن الأفراد. أما اجتماع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في يد جهة واحدة فهو سيؤدي إلى ممارسة القمع لأن "القاضي سيمتلك قوة القامع". ويكون الأمر أكثر سوءا وتعارضا مع تحقيق غايات الدولة حينما تجتمع كل هذه السلط الثلاث في يد جهة واحدة تكون هي المشرع والمنفذ والحكم في نفس الآن، ففي مثل هذه الحالة لا أمن ولا حرية، بل كما يقول مونتسيكيو في جملة شديدة الاقتضاب عميقة الدلالة "كل شيء سيتعرض للضياع". إلى جانب شرط فصل السلط، يضيف أصحاب نظرية العقد الاجتماعي شرطا آخر ينبغي أن يتوفر في السلطة السياسية كي تحقق غايات الدولة من حرية وأمن ..الخ، وهو أن تكون هذه السلطة نابعة من إرادة الأفراد أنفسهم، فلما كان هؤلاء كما يقول جون لوك "أحرارا ومتساوين بالطبع، استحال تحويل أي منهم عن هذا الوضع وإكراهه على الخضوع لسلطة إنسان آخر دون موافقته التي يعرب عنها مع أقرانه على تأليف جماعة واحدة و الانضمام إليها"، وتبعا لهذا فإن الخضوع لسلطة الدولة ليس شيئا آخر غير الخضوع لسلطة الأفراد أنفسهم ولما تقرره إرادتهم أو على الأقل إرادة الأغلبية أو الأكثرية منهم. فالسلطة السياسية يجب دوما أن تعمل كهيأة واحدة، وأن تتحرك في اتجاه واحد، وهذا الاتجاه لن يكون سوى واحد من أمرين: إما أن يكون هو ما تقرره إرادة كل الأفراد المكونين للدولة (الإجماع)، وإما أن يكون هو ما تقرره إرادة الغالبية منهم، "فقرار الأغلبية يعتبر بمثابة قرار المجموع" كما يقول جون لوك ويردد ذلك روسو من بعده أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة وموضع. بغض النظر عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في السلطة السياسية، تبقى هذه الأخيرة في نظر الفلاسفة السالفين الذكر تتجسد في أجهزة ومؤسسات ظاهرة ومشخصة: فالسلطة التشريعية تتجسد في مؤسسة البرلمان وفي النواب الذين يجتمعون بداخله، أما السلطة القضائية فتتجسد في المحاكم وفي القضاة والمستشارون الذين يشتغلون بها، وأخيرا تتجسد السلطة التنفيذية في مختلف المؤسسات العقابية وفي مختلف الأجهزة التي تحتكر امتلاك السلاح والحق في استخدامه من شرطة ودرك وجيش.انسجاما مع تصورها للدولة، باعتبارها أداة للهيمنة الطبقية، تضيف الماركسية ـ خصوصا في شقها البنيوي مع ألتوسيرـ أجهزة أخرى تعتبرها أساسية في ممارسة الدولة للسلطة، وتتمثل هذه الأجهزة، التي يسميها التوسير "بالأجهزة الإيديولوجية" للدولة، في المدرسة والنقابة والحزب والإعلام والأسرة ومختلف الأجهزة الدينية والثقافية وغيرها من الأجهزة التي من خلالها تبرر الدولة ممارساتها وتمرر عبرها غاياتها، والتي هي في نهاية التحليل ليست سوى ممارسات وغايات الطبقة المسيطرة. وتتميز هذه الأجهزة حسب ألتوسير عن سابقاتها، وخصوصا عن تلك التي تسمى في الأدبيات الماركسية "بالجهاز القمعي للدولة" (الشرطة، الدرك، الجيش)، في أمرين اثنين: أولهما أن الجهاز القمعي موحد في قيادته وتوجهاته بينما الأجهزة الإيديولوجية كثيرة ومتعددة سواء في قياداتها أو في توجهاتها. ثانيهما أن الجهاز القمعي ينتمي كله إلى المجال العمومي بينما الأجهزة الإيديولوجية فهي " على عكس ذلك تنتمي إلى المجال الخاص، الكنائس خاصة، وكذا الأحزاب، والنقابات، والعائلات، وبعض المدارس، ومعظم الصحف . . . الخ". لم تعد السلطة السياسية مع التوسير إذن ذات طبيعة مادية مشخصة، بل هي قد تكون "غير منظورة بشكل مباشر" فتمارس فعلها على الأفراد حيث لا يدرون وهذا التصور هو ما سيتعمق أكثر مع جملة من الفلاسفة المعاصرين، مثل هوركهايمر، أدرنو، ماركيوز، فوكو. ففي رأي هذا الأخير مثلا للسلطة حضور أوسع وأعمق مما تصور التوسير، فهي موجودة في كل زمان ومكان، وفي كل مستويات الحياة الفردية والجماعية، فهي تحضر في اللغة والفن وكل أشكال وصور العلاقات القائمة بين الناس. فحصر عمل السلطة في أجهزة قمعية عقابية وأخرى إيديولوجية كما ذهب إلى ذلك ماركس والتوسر وكل المتأثرين بأفكارهما يدل في رأي فوكو على عدم معرفة بالمدى الذي تتغلغل فيه السلطة في مفاصل ومكونات المجتمع. فالسلطة حسب فوكو كثيرا ما تبتعد عن القمع بل و عن الايدولوجيا أيضا لتلتجئ إلى أساليب وفنون وتقنيات مركبة ومعقدة مثل تقسيم الناس إلى ذكور وإناث، أطفال وشباب، وتقسيم الأجناس الأدبية إلى شعر ونثر، قصة ورواية . . الخ. وبذلك فإن السلطة ليست مجرد جهاز أو مؤسسة لها وجود مستقل ومتعال عن المجال الذي تمارس فيه، وإنما هي ممارسة وفعل ملازمين ومحايثين لكل علاقات القوى القائمة داخل المجتمع وهو ما يجعلها كما يقول فوكو" حالة في كل مكان وتأتي من كل صوب". ليس للسلطة السياسية إذن طبيعة واحدة، ولا طريقة موحدة في الاشتغال، فهي قد تتخذ طبيعة مادية ظاهرة ومن المقابل قد تتخذ طبيعة معنوية خفية فقد تشتغل عن طريق القمع والعنف، وقد تشتغل عن طريق الإقناع والتبرير. هذه المفارقات تجعلنا أمام إشكالية جديدة وهي إشكال الدولة بين الحق والعنف. المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف بغض النظر عن أصل الدولة ومنشؤها، وعن طبيعة سلطها وأجهزتها، فتبقى إحدى الغايات الأساسية لوجودها هو تحقيق الأمن والاستقرار للأفراد الذين يؤلفونها، وجعل العلاقات القائمة فيما بينهم تنبني على الحق والقانون وليس على القوة والعنف. غير أنه من أجل تحقيق هذه الغاية عادة ما تلجأ الدولة نفسها إلى القوة والعنف، فتكون هي نفسها طرفا في حروب وصراعات. فهل يحق للدولة ذلك؟ أليس من التناقض أن تلجأ الدولة إلى القوة والعنف من أجل إلغاء القوة والعنف؟ أم أن عنف الدولة هو بالمقابل عنف من نوع آخر، عنف مشروع وقانوني، يمتلك مشروعية من القوانين التي تنظمه؟ يعتبر 'ماكيافيلي' من كبار الفلاسفة الذين دافعوا عن مشروعية استخدام الدولة للعنف والقوة، بل ولما هو أسوء منهما، المكر والخديعة. فالأمير الذي يمثل أعلى نقطة في هرم السلطة، القائد الأعلى لمختلف أجهزتها ومؤسساتها، يجب عليه، يقول ماكيافيلي، "أن يجيد استعمال اسلوب الحيوان وأسلوب الإنسان على حد سواء(...)، وأن يقوم بالاستغلال الجيد لكلا الطبيعتين". وإذا كان أسلوب الإنسان يعني العمل وفق القانون ووفق ما تقتضيه الفضائل الأخلاقية الحقة، من رحمة ووفاء وإحسان ونزاهة وإنسانية، فإن أسلوب الحيوان يعني العمل وفق مبدأ القوة ومبدأ المكر معا،"فالأمير- يقول ماكيافيلي – عليه أن يقلد الأسد والثعلب معا، لأن الأسد لا يحمي نفسه من الشراك، والثعلب لا يقوى على التصدي للذآب". ولا يعني هذا أن ماكيافيلي ينصح الأمير بأن يتصرف دوما حسب الطبيعة الحيوانية، أي بقوة ومكر، بل يعتبر ذلك خطرا عليه، وإنما بنصحه فقط " بأن يكون على أهبة الاستعداد للتغير حسب مقتضيات الظروف ومجريات الأحداث،" أي " أن لا يمتنع عن القيام بأعمال الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مع ضرورة اللجوء إلى استعمال الشر عند الاضطرار". وهو المعنى الذي سيعبر عنه المبدأ الشهير في الماكيافيلية " الغاية تبرر الوسيلة"، فحينما يكون هناك خطر يهدد عرش الأمير، أو أمن الجماعة واستقرارها فيصبح من حق الدولة أن تلجأ إلى القمع والعنف بدل الحق والقانون، ومن واجب الأمير أن يلجأ إلى القوة والمكر بدل العدل والنزاهة، لكن بمجرد أن يزول ذلك الخطر فيجب أن تعود الأمورإلى مجراها الطبيعي، أي أن تعود القوانين كي تحكم ممارسات الدولة والأخلاق الفاضلة لتوجه أفعال الأمير. إن اعتقاد مكيافيلي بأن لجوء الدولة إلى العنف هو أمر استثنائي وليس أبدا قاعدة، سيجعله ينصح الأمير لا بأن يكون بالضرورة قويا وماكرا، وإنما بأن يتظاهر بذلك فقط. فما يهم بالضبط ليس هو حيازة هذه الصفات بالفعل وإنما المهم هو التظاهر بامتلاكها وبالقدرة على التصرف وفقهما إن اقتضت الضرورة.رغم ارتباط أفكار ماكيافيلي بأوضاع سياسية محددة، هي أساسا أوضاع إيطاليا في النصف الأول من القرن 16، إيطاليا المفككة والممزقة إلى ممالك متحاربة ومتطاحنة فيما بينها، فإن هذه الأفكار لا زالت إلى عصرنا هذا تمتاز بكثير من الراهنية: تعمل وفقها كل الدول ويتبناها عدد غير قليل من الفلاسفة. فليس هناك دولة إلى اليوم لا تلجا إلى القمع بعنف وقوة من أجل تحقيق هذا الهدف أو ذاك، وتمرير هذه السياسة أو تلك. كما أن عددا من المفكرين والفلاسفة يعتبر ذلك أمرا مبررا ومشروعا. فالماركسية بكل مدارسها وتوجهاتها تعتبر العنف والقمع هما الركيزة الأساسية التي تقوم عليها كل دولة، فهذه الأخيرة بقدر ما هي وليدة الصراع بقدر ما هي التجسيد المادي والواقعي له، وإذا ما انتفى فإن الدولة نفسها ستنتفي معه، وستصبح كما يقول إنجلز "في متحف الأثريات بجانب العجلة والفأس البرونزي"، وهو نفس التصور الذي نجده عند أحد من كبار المفكرين الاجتماعيين والسياسيين في القرن20 وهو ماكس فيبر، فهو الآخر يؤكد غير ما مرة بأن "علاقة الدولة بالعنف هي علاقة حميمية جدا" موضحا أن "كل دولة تنبني بالضرورة على القوة" و"بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة للدولة، وهو وسيلتها الخاصة أيضا"، أي أن الدولة وحدها من يمتلك الحق في استخدام العنف وفي السماح لمجموعات معينة بممارسته" إنها كما يقول فيبر"المصدر الوحيد للحق في العنف" الذي يتميز بناء على ذالك بكونه "عنف مشروع". غير أن القول بأن العنف والقوة أدوات أساسية في ممارسة الدولة للسلطة، لا يعني اختزال هذه الأخيرة فيهما. "فان نمنح الدولة امتياز العنف المشروع – يقول بول ريكور – لا يعني تعريفها انطلاقا من العنف، وإنما انطلاقا من السلطة" والسلطة لا تنحصر في ممارسة القوة والعنف فقط وإنما تتعدى ذلك إلى التربية والإعلام والأحزاب والنقابات ...الخ، وتبعا لهذا فإن العنف والقوة لن يكونا ممارسة فعالة من قبل الدولة ما لم تكن هذه الأخيرة تمتلك إيديولوجيا معينة تقنع بها مواطنيها، وتربي عليها أجيالها المتلاحقة، "فكل دولة، يقول عبد الله العروي، لا تملك أدلوجة تضمن درجة مناسبة من ولاء وإجماع مواطنيها لا محالة مهزومة". فالعنف أداة ووسيلة وليس أبدا غاية وهدف، ولا يمكنهما أن يؤديا إلا إلى الفوضى والخراب ما لم يكن هناك مشروع مجتمعي واضح المعالم تعمل الدولة على الإقناع به والتربية عليه أولا ، ولا تلجأ إلى معاقبة من برفضه ويعيق تنفيذه إلا بعد ذلك. واضح من كل ما سبق، أن الدولة كإطار للانتظام السياسي وللحياة الاجتماعية تطرح جملة من الإشكالات وتنطوي على عدد من المفارقات التي لا يمكن استيعابها وفهمها على الوجه الأكمل إلا بالانفتاح على مفاهيم أخرى عدة، وعلى ما تطرحه هي أيضا من إشكالات ومفارقات، ومن أبرز هذه المفاهيم: مفهوم العنف، مفهوم الحق، مفهوم العدالة، مفهوم الحرية، مفهوم الواجب . . الخ. | |
|